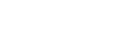نشرت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي مقالًا يناقش أعمق التحديات التي تواجه الدولة السورية في مرحلة انتقالية مضطربة، مسلطة الضوء على أحداث السويداء الأخيرة وما كشفته من تصدعات في بنية الدولة المركزية.
واجهت سوريا، بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، معركة من نوع جديد، وهي إعادة تشكيل الدولة وسط تداخل معقّد للديناميات المحلية والإقليمية. كشفت أحداث السويداء، التي سرعان ما انزلقت إلى العنف الطائفي، حدود السيطرة المركزية، وعرّت هشاشة محاولات فرض السيادة على مجتمعات محلية مضطربة. جنوب سوريا، وهو منطقة تنازع نفوذ تاريخية، عاد إلى الواجهة كساحة صراع امتزجت فيها المحليّة بالطائفية، وتقاطعت السياسة الوطنية بالطموحات الإقليمية.
بدأت الاشتباكات بخطف تاجر خضار درزي على يد جماعة بدوية، في منطقة تشهد توترًا مزمنًا بين الطائفتين. تصاعد الحادث بسرعة إلى أعمال عنف طائفية واسعة، شملت هجمات انتقامية وإعدامات ميدانية. أرسل أحمد الشرع، رئيس الحكومة الانتقالية، قوات عسكرية لاستعادة النظام، لكن العملية أخفقت عسكريًّا وسياسيًّا، بعد اتهام القوات بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين دروز. في الأثناء، استغلّت إسرائيل اللحظة لتفعيل قرارها بإبقاء الجنوب السوري منزوع السلاح، وقصفت وزارة الدفاع السورية في دمشق ومنطقة قرب القصر الرئاسي، بذريعة حماية الدروز في السويداء. تدخّل وسطاء دوليون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لاحتواء التصعيد، وأسفر ذلك عن اتفاق سُحبت بموجبه القوات السورية من السويداء، واستقرّ وقف هشّ لإطلاق النار.
خلال ذروة الاشتباكات، احتشدت قبائل بدوية على مشارف السويداء تضامنًا مع أقربائها، دون قيادة موحدة، مما حوّل الصراع المحلي المحدود إلى نزاع متعدد الأطراف ذي تداعيات إقليمية. تلاقت ثلاثة مسارات خطيرة: سعي الدروز إلى الحماية، رغبة القيادة السورية في فرض سلطتها بالقوة، وطموح إسرائيل لتوسيع نفوذها في الجنوب. فسّرت دمشق إشارات إسرائيلية – قيل إنها صدرت خلال محادثات في باكو – كضوء أخضر للتقدم نحو السويداء، فيما رأت تل أبيب ذلك تجاوزًا للاتفاقات. النتيجة كانت كارثية: سفك دماء، أزمة ثقة في القيادة، وتركيبة سلطة جديدة في الجنوب.
تجاوزت الأزمة كونها حادثًا أمنيًا عابرًا، لتغدو ضربة موجعة للنسيج الاجتماعي السوري. حفّز العنف الاستقطاب الطائفي، وهدّد عملية الانتقال السياسي، وأضعف إمكانية التعايش بين مكونات المجتمع والدولة الناشئة. سعى النظام لتأطير الأزمة في ثنائية خير وشر، متهماً الشيخ حكمت الهجري بالخيانة، بينما تجاهل السياق الأوسع: تغلغل إسرائيل في الجنوب جاء نتيجة انسحاب السلطات المركزية وغياب الأمن الشامل.
لم يكن الجنوب يومًا منطقة هامشية. منذ 2013، أصبح ساحة اختبار لمشاريع نفوذ متعددة: من محاولات إيران لتشكيل قوات موالية، إلى تجربة "الجبهة الجنوبية" بدعم أمريكي وخليجي. أعادت هذه التجارب رسم خريطة الجنوب كمسرح تنافس إقليمي. اليوم، يبدو أن إسرائيل تحاكي النموذج التركي في الشمال، ببناء منطقة نفوذ عبر ترتيبات محلية غير رسمية، مدعومة بحماية أمنية خارجية، تخدم مصالحها دون تدخل مباشر. هذا النموذج يعكس منطق "الحدود المرنة"، حيث السيادة غير واضحة، وتُستبدل بتفاهمات عائمة تنفّذ أجندات خارجية.
يشكّل هذا الواقع خطرًا وجوديًّا، ليس فقط بسبب تداعياته العسكرية، بل لما يخلّفه من هشاشة اجتماعية دائمة. تكريس السويداء كمجال نفوذ خارجي يعمّق منطق "الكانتونات"، ويحوّل كل نزاع محلي إلى فتيل إقليمي أو دولي، ويعيد إنتاج معادلة قاتلة: غياب الثقة بين السوريين، وانعدام القيادة الموحدة.
أبرزت أحداث السويداء انهيار جدوى النموذج البعثي في بناء دولة مركزية. لم يكن العنف معزولًا، بل امتدادًا لما شهدته مناطق الساحل سابقًا من تعبئة أيديولوجية وطائفية عزّزت الانقسامات. في دولة ضعفت فيها المؤسسات أو تلاشت، مثل سوريا، – وحتى في لبنان بدرجة أقل – أصبح السلاح والهوية الطائفية وسيلتين للبقاء.
هذا النمط من العنف لا يقتصر على الجنوب أو الساحل. قد يمتد إلى الشرق الكردي، أو إلى حدود لبنان حيث تسكن الطائفة الشيعية في البقاع. في بيئات كهذه، يصبح العنف أداة للإكراه وتشكيل الهوية الجماعية، في ظل غياب الدولة.
تحتاج سوريا بعد الحرب إلى أكثر من مجرد إصلاح مؤسسي. تتطلب إعادة تعريف جذري لطبيعتها السياسية. لا تكفي إعادة نشر القوات أو فرض السيطرة، بل يجب تبنّي خيال سياسي جديد يعترف بتعدد مراكز القوة، ويؤمن بالحكم التشاركي وإدارة النزاعات بالتفاوض، بعيدًا عن أوهام الدولة الموحدة الصلبة، التي لم تعد قابلة للتحقق.
https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2025/07/the-syrian-state-after-suwayda?lang=en¢er=middle-east