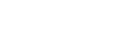بين خطاب يمجّد "الرئيسة اللي باعت طائرتها" في كرواتيا، وخطاب يومي في مصر عن دولة تبيع أرضها وأصولها وتستنزف مواطنيها بالضرائب والديون، تتجسد فجوة هائلة ليست في الموارد ولا في الجغرافيا، بل في القيم والرؤية وطبيعة القيادة.
القصة المتداولة عن الرئيسة الكرواتية Kolinda Grabar-Kitarović التي "باعت الطائرة الرئاسية ومرسيدس الوزراء وقلّصت راتبها" ثبت أن كثيرًا من تفاصيلها مبالغ فيه أو غير دقيق؛ فوكالات تحقق دولية أوضحت أنها لم تَبِع طائرة رئاسية لأنها أصلاً لا تمتلك صلاحية ذلك، وأن أسطورة "35 مرسيدس" جزء من رواية شعبوية منتشرة عالمياً أكثر من كونها واقعًا موثّقًا.
لكن المفارقة أن الأرقام الحقيقية في كرواتيا تظل رغم ذلك صادمة مقارنة بوضعنا: ناتج محلي إجمالي ارتفع من نحو 10.6 مليار دولار في أوائل التسعينيات إلى أكثر من 92 مليار دولار في 2024، بفضل مسار طويل من الإصلاح المؤسسي، والاندماج في الاتحاد الأوروبي، وسياسات أقرب للعقل من "الاستعراض".
في المقابل، تبدو مصر نموذجًا لدولة اختارت الطريق الأسهل والأخطر: ديون تتضخم، وأصول استراتيجية تُباع أو يُتنازل عن حق الانتفاع بها لعقود طويلة، وبرلمان ضخم لا يمارس رقابة حقيقية، بينما المواطن يُستدعى فقط ليدفع الفاتورة.
كرواتيا: قصة تُروى عن التقشف.. وحقيقة تقول إن الإصلاح يبدأ من القمة
حتى لو كان جزء كبير من الحكاية المتداولة عن الرئيسة الكرواتية أسطورة شعبية، فإنها تعبّر عن فكرة جوهرية: في الدول التي تحترم نفسها، الإصلاح يبدأ من فوق، من طريقة حياة المسؤولين، من علاواتهم، من أساطيل سياراتهم وسفرياتهم، ومن استعدادهم قبل غيرهم لتحمّل الألم.
النموذج الكرواتي الحقيقي لم يُبنَ على بيع طائرة ولا تقليص 35 مرسيدس، بل على مسار طويل من بناء مؤسسات، احترام قواعد اللعبة السياسية، توسيع قاعدة الإنتاج، والاستفادة الذكية من الانضمام للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يستخدم الناس قصة "الرئيسة المتقشّفة" كرمز لشيء نفتقده: أن ترى مسؤولًا يقول صراحة "لن نرهن قرارنا لمؤسسات التمويل الدولية، وسنشد الحزام على أنفسنا قبل الناس".
في كرواتيا، ورغم كل التعقيدات، لم تُبع الأصول الاستراتيجية بالجملة، لم تُحوّل الموانئ إلى سلعة تُتناقل بين الصناديق السيادية، ولم تُقدَّم الأراضي الساحلية والتاريخية على طبق من ذهب لسد فجوة تمويل عام أو لتلميع صورة سياسية آنية. الإصلاح هناك – مهما اختلفنا حوله – لم يقم على تصفية رأس المال القومي، بل على تعظيمه.
الدرس هنا بسيط وقاسٍ في الوقت نفسه: حتى حين تبالغ الرواية الشعبية في تمجيد زعيمة ما، فإنها تختار أن تبالغ في اتجاه "التقشف من أعلى" لا في تلميع ديون ولا في تسويق بيع الأصول كـ"فتح اقتصادي عظيم".
مصر: ديون تتراكم، أصول تُصفّى، ومواطن يتحول إلى ضامن إجباري
على الضفة الأخرى، تقف مصر تحت حكم عبد الفتاح السيسي كحالة مدرسية لدولة تُحمِّل قاعدتها الاجتماعية كل الأعباء، بينما تبقي قمتها في منطقة آمنة من الألم الحقيقي. الدين الخارجي وحده قفز إلى نحو 156 مليار دولار في 2024، أي ما يقارب 40–42% من الناتج المحلي، فيما يظل الدين العام الإجمالي عند مستويات تفوق 80% من الناتج، مع تحذيرات دولية متكررة من مخاطر "ضغط الديون" على الأجيال القادمة.
في الخطاب الرسمي، يُقال إن هذه القروض "تمويل للتنمية". لكن أين التنمية حين يتحوّل الاقتصاد إلى ورشة إسمنت مفتوحة: أبراج في الصحراء، عواصم إدارية لامعة، مدن فاخرة على الساحل، مقابل مدارس حكومية تتداعى، ومستشفيات عامة تنهار تحت الضغط، وريف يزداد فقرًا وبطالة؟ تقارير اقتصادية مستقلة ترى أن كثيرًا من النمو المُعلن في السنوات الأخيرة هو نمو اسمي تغذّيه موجات التضخم الضخمة والمشروعات العقارية التي لا تخلق قيمة إنتاجية مستدامة ولا وظائف كافية، في ظل بيئة تخنق القطاع الخاص لصالح شركات تابعة للدولة والجيش.
الدولة التي تتشدّق بـ"تشجيع الاستثمار" تبادر في الوقت نفسه إلى بيع أو منح حق انتفاع طويل الأجل لمناطق استراتيجية على الساحل والبحر، وموانئ حيوية، وأصول ربحية مملوكة للشعب، لسد فجوات تمويل عاجلة وتهدئة الأسواق، من صفقة "رأس الحكمة" إلى مشروعات أخرى لا تقل حساسية. هذه ليست رؤية، بل تصفية منظمة لرأس المال القومي تحت لافتة "الإصلاح".
في الموازنة، الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من جيوب الناس عبر الضرائب والرسوم؛ فالحكومة تتفاخر بزيادة الحصيلة الضريبية، بينما تعترف في الوقت نفسه بأن خدمة الدين تلتهم نسبة هائلة من الإنفاق العام. ميزانية 2025/2026 مثلاً تُظهِر عجزًا بنحو 30 مليار دولار رغم توسّع غير مسبوق في الضرائب، في بلد لم تُرفع فيه كفاءة جهاز الدولة ولا أُصلح فيه نظام الأجور ولا فُتح المجال فعلاً أمام استثمار منتج يخلق وظائف.
يُجبى من المواطن كل شيء: ضريبة على كل فاتورة، وكل معاملة، وكل سلعة، حتى بات من المشروع السؤال: ماذا تنتج الدولة بالضبط؟ إذا كانت 80–90% من مواردها تأتي من الضرائب والاقتراض وبيع الأصول، فأين الصناعة؟ أين الزراعة؟ أين التكنولوجيا والخدمات عالية القيمة؟
برلمان ضخم بعضويته – 596 نائبًا في مجلس النواب و300 في مجلس الشيوخ – ومجالس ولجان وحوافز وبدلات وسفر ومكاتب فخمة، لكن وظيفة الرقابة تكاد تكون معدومة، ومعظم القوانين تمرّ كما جاءت من السلطة التنفيذية، في مشهد أقرب إلى "ختم" رسمي منه إلى سلطة تشريعية حقيقية.
الأخطر من كل ذلك أن المصري صار ضامنًا إجباريًا لديون لم يُستشر فيها، وشريكًا بالقوة في مشروعات لم تُعرض عليه، ومطلوبًا منه أن يدفع ثمن قرارات لم يشارك في صناعتها. تُفرض عليه ضرائب ورسوم جديدة، بينما يُطالَب بالصبر باسم "الوطن" و"الإصلاح"، في حين تُحمى طبقات ضيقة حول السلطة من أي ألم حقيقي، وتتضخّم امتيازات النخبة السياسية والأمنية والإدارية.
الخلاصة أن الفرق بيننا وبين أي دولة نهضت من العدم ليس في الموارد ولا في "خريطة الاستثمار"، بل في القيم التي تحكم القرار: هل التضحية تبدأ من القمة أم تُلقى بالكامل على القاعدة؟ هل تُصان الأصول الاستراتيجية أم تُصفّى لسد فجوة عجز سنة أو سنتين؟ هل يُعامل المواطن كشريك صاحب حق أم كضامن وممول إجباري؟
الانهيار لا يحدث فجأة. يبدأ لحظة تتحوّل القرارات العشوائية والصفقات السريعة إلى بديل عن رؤية وطنية طويلة المدى، ولحظة يصبح بيع الأرض أسهل من إصلاح جهاز الدولة، ورفع الضرائب أيسر من مواجهة الفساد وسوء التخطيط. مصر ليست فقيرة في الموارد، لكنها محاصَرة بفقر في الضمير والرؤية والاستراتيجية، وهذا – قبل أي شيء آخر – هو جوهر أزمتها.