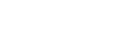في فجر الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦، ظهر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسط طلاب وضباط الأكاديمية العسكرية المصرية، ليعلن بكل وضوح أن طريق الوظائف العليا في الدولة، بما فيها القضاء، لن يمر إلا من بوابة المؤسسة العسكرية.
تحدث عن "معايير موضوعية مجردة دون مجاملة"، وعن "تحقيق الجدارة"، نافياً أن تكون الدورات التي يخضع لها القضاة هدفها "صناعة نخبة متعالية".
لكن خلف هذه العبارات المنمّقة، كان يتكرّس واقع جديد: قضاء تحت الاختبار العسكري، وقضاة مطالبون بالانصياع لا بالاستقلال.
في المقابل، شهدت أروقة نادي قضاة مصر حراكاً غير مسبوق؛ اجتماعات طارئة، بيانات قلقة، ودعوات لجمعية عمومية مطلع فبراير ٢٠٢٦، رفضاً لما تردد عن سحب ملف التعيينات والترقيات من الهيئات القضائية، وإسناده عملياً للأكاديمية العسكرية.
ورغم محاولة مجلس القضاء الأعلى امتصاص الغضب، والتأكيد في بيانات رسمية أن شؤون التعيين والترقية "اختصاص حصري للقضاء"، فإن الواقع على الأرض يقول شيئاً آخر تماماً.
بهذا المعنى، لم تعد الأزمة مجرد سوء تفاهم إداري، بل مؤشر على صدام مفتوح بين مشروع يسعى لعسكرة كل ما تبقى من مدنية في الدولة، ومنظومة قضائية ساهمت لسنوات في تثبيت الحكم العسكري، لتجد نفسها اليوم أمام امتحان حقيقي: إما الخضوع الكامل، أو دفع ثمن متأخر لمحاولة التمسك بما تبقى من استقلال شكلي.
من شريك في الانقلاب إلى سلطة تحت التدريب العسكري
منذ ما بعد ثورة يناير، لعبت مؤسسة القضاء دور "الشريك الموثوق" للنظام العسكري.
فقد كانت المحكمة الدستورية العليا هي الأداة التي حلت أول برلمان منتخب، ومهّدت لفراغ سياسي استُخدم لاحقاً لتبرير عودة الحكم الأمني.
ثم جاء دور الهيئات القضائية في دعم تحركات ٣ يوليو ٢٠١٣، سواء عبر خطاب "الشرعية القضائية" أو عبر غطاء قرارات استثنائية ورسائل سياسية في ثوب أحكام.
في قلب هذه الشراكة، برز اسم عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الذي قبل القيام بدور "الرئيس المؤقت" بعد الانقلاب، مكتفياً بالتوقيع على ما يُعرض عليه من قوانين وقرارات، من بينها ترقية السيسي إلى رتبة "مشير" رغم عدم مشاركته في أي حرب، في سابقة هزأت من المنطق العسكري نفسه قبل أن تهز هيبة القانون.
لكن ما اعتقده القضاة "شراكة" كان، في نظر السيسي، مجرد مرحلة انتقالية. فبمجرد تثبيت أركان حكمه، بدأ في إعادة هندسة مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى: الإعلام جرى تدجينه عبر الاستحواذ الأمني والمالي؛ البرلمان تحوّل إلى قاعة تصفيق بعد إعادة تشكيله أمنياً؛ النقابات جرى تفريغها من مضمونها.
ومع الوقت، أصبح واضحاً أن القضاء لن يبقى بمنأى عن هذا المسار، وأن "الاستقلال" الذي تغنّى به بعض رموزه لن يصمد أمام مشروع قائم على إخضاع كل السلطات لقرار الجنرال.
تصريحات السيسي الأخيرة عن "استعلاء" بعض الفئات، ورفضه لأي "نخبة متعالية"، لم تُقرأ داخل الوسط القضائي إلا كتجريح مباشر، ورسالة فجة: أنتم، مثل غيركم، ستُعاد صياغتكم على المقاس العسكري، ومن يرفض سيجري تهميشه أو إخراجه من اللعبة تماماً.
الأكاديمية العسكرية.. بوابة إجبارية لعسكرة المنصة
منذ سنوات، بدأت الأكاديمية العسكرية تمد نفوذها خارج إطارها التقليدي، لتتحول تدريجياً إلى "دولة داخل الدولة": تأهيل قيادات الوزارات، تدريب نواب البرلمان، تمرير دفعات من المعينين الجدد في الجهاز الإداري، وصولاً إلى تخريج دفعة من القضاة بعد تدريب عسكري مكثف استمر ستة أشهر في ٢٠٢٤، وهو ما أثار وقتها انتقادات داخل دوائر قضائية وحقوقية، لكون التدريب يركز على الاختبارات البدنية والنفسية أكثر من المعايير القانونية والمهنية.
الجديد في ما يجري الآن أن الأمر لم يعد مجرد "دورات اختيارية" أو مجاملات بروتوكولية، بل انتقل إلى مستوى أخطر: ربط التعيين والترقية في النيابة والقضاء العملي باجتياز بوابة الأكاديمية.
تقارير صحفية وتسريبات قضائية تحدثت عن نقل ملف التعيينات إلى "لجان مشتركة" تمر عبر الأكاديمية، وعن دور متزايد للجهات العسكرية في تقييم المرشحين بدنياً ونفسياً قبل وصولهم للمنصة.
وفي الأيام الماضية، سُرّبت مذكرة من مكتب تعيينات الأعضاء بمكتب النائب العام تضم ٧٩٠ اسماً مرشحاً للتعيين بدرجة معاون نيابة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، في ما فُسر من جانب بعض القضاة بوصفه محاولة للتمسك بدور المكتب في مواجهة مساعي نقل الملف بالكامل إلى الأكاديمية.
في المقابل، أصر السيسي خلال زيارته الأخيرة للأكاديمية، ٣٠ يناير ٢٠٢٦، على أن الهدف من الدورات هو "تحقيق المصلحة" و"ضمان الجدارة"، نافياً أن تكون وسيلة لـ"الاستقطاب أو التمييز".
لكن هذا الخطاب الرسمي يتناقض جذرياً مع حقيقة أن مؤسسة واحدة، ذات طبيعة عسكرية، تطمح عملياً لأن تكون المرجعية العليا لاختيار قضاة مصر، في انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات، وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء التي تحذر من أي تدخل تنفيذي أو أمني في مسارات التعيين والتأهيل المهني.
بهذا المعنى، تتحول الأكاديمية إلى "فلتر سياسي وأمني" قبل أن تكون مركز تدريب؛ من يمر عبرها ليس فقط من أثبت كفاءته العلمية، بل أيضاً من أثبت استعداده للاندماج في عقلية النظام، وولاءه لمنظومة ترى في القضاء أداة لإدارة الخصوم، لا مؤسسة لحماية الحقوق والحريات.
خيارات القضاة: امتيازات تحت الوصاية أم كرامة بلا حصانة؟
حركة مجلس القضاء الأعلى في الأيام الأخيرة عكست حالة ارتباك حقيقية. فبين بيانات تطمينية تؤكد أن "استقلال القضاء خط أحمر" و"أن المجلس هو المختص دستورياً بالتعيين والترقية"، وبين تأجيل الجمعية العمومية التي دعا إليها نادي القضاة، بدا أن هناك محاولة لشراء الوقت، على أمل أن تمر العاصفة بأقل قدر من الخسائر.
لكن السؤال الأهم لم يعد: ماذا يريد السيسي من القضاء؟ فهذا صار واضحاً؛ المطلوب منصة منضبطة، خالية من الأصوات المزعجة، لا ترفع رأسها أمام "التوجيهات العليا"، وتتعامل مع الخصوم السياسيين باعتبارهم ملفات أمنية لا متقاضين لهم حقوق.
السؤال الحقيقي الآن: ماذا يريد القضاة لأنفسهم ولمؤسستهم؟
جزء لا بأس به من القضاة، خصوصاً من استفادوا من الامتيازات المادية والوظيفية في عهد السيسي، يميل إلى خيار "الصمت مقابل الاستمرار": غضب مكتوم في الغرف المغلقة، لكن بلا استعداد لتحمل كلفة مواجهة حقيقية مع سلطة لا تتورع عن كسر أي مؤسسة تعترض طريقها.
هؤلاء يراهنون على أن النظام، كالعادة، سيقدم بعض المسكنات الشكلية، ثم يواصل تمرير مخططه على مراحل.
في المقابل، تكشف تسريبات الاجتماعات الأخيرة، وحملة الوسوم المتداولة على مواقع التواصل مثل "المنصة حقها" وغيرها، عن وجود تيار داخل القضاء بدأ يدرك أن ما يجري ليس خلافاً عابراً، بل مسماراً جديداً في نعش هيبة القضاء نفسه؛ وأن قبول وضع المنصة تحت وصاية ضباط الأكاديمية يعني عملياً أن القاضي لم يعد يحكم "باسم الشعب"، بل باسم الجهة التي وقّعت على تقرير اللياقة البدنية والنفسية الخاص به.
بين هذين الخيارين، يقف القضاء المصري عند لحظة فارقة: إما أن يُستكمل تحويله إلى جهاز تابع، يضفي شرعية شكلية على قرارات سلطة عسكرية متغولة، أو أن يقرر جزء من داخله كسر حلقة "الشراكة الصامتة" التي بدأت منذ ما قبل ٣ يوليو، ويدفع ثمن محاولة متأخرة لاستعادة جزء من استقلاله وكرامته.
حتى الآن، الأرجح أن النظام سيلجأ إلى "احتواء محسوب": بعض التعديلات الشكلية في مسارات التعيين، خطاب رسمي ناعم عن "احترام القضاء"، وربما تجميد مؤقت لبعض البنود الأكثر استفزازاً، مقابل استمرار الجوهر: عسكرة بطيئة، لكنها ثابتة الخطى، لمنصة كان يُفترض أن تكون آخر خطوط الدفاع عن فكرة القانون في دولة تتآكل فيها المؤسسات، واحدة تلو الأخرى، تحت حذاء الجنرال.