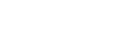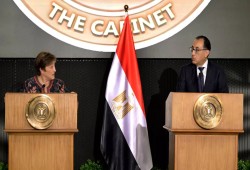بعد عامين من العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي زعزع استقرار المنطقة ووضعها فوق "برميل بارود"، تحاول الحكومة المصرية تصوير اتفاق وقف إطلاق النار الأخير كمنفذ للنجاة وفرصة للانتعاش الاقتصادي. غير أن الواقع يكشف عكس ذلك تمامًا: فبينما تتحدث السلطة عن “الاستقرار الإقليمي”، يبدأ المصريون بإحصاء خسائرهم التي كشفت عن هشاشة عميقة في بنية الاقتصاد، نتجت بالأساس عن سوء الإدارة والاعتماد المفرط على القروض والجباية. المواطن اليوم هو من يدفع ثمن تلك السياسات، من تآكل قدرته الشرائية إلى اتساع الضغوط المعيشية.
صدمات متعددة في شرايين الاقتصاد
يصف الخبير الاقتصادي أحمد خزيم الوضع بدقة حين يقول إن العدوان أصاب الاقتصاد المصري "في مقتل"، لكن ما عمّق الجرح هو غياب رؤية اقتصادية حكومية قادرة على التعامل مع الصدمات.
فقد تسببت الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب تخبط السياسات الداخلية، في انهيار إيرادات حيوية وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن إلى مستويات غير مسبوقة، مما انعكس على جميع القطاعات.
- قناة السويس: كانت الضحية الأبرز، إذ كشف عمرو السمدوني، رئيس شعبة اللوجستيات والنقل الدولي، أن دخل القناة تراجع في السنة المالية 2023-2024 إلى نحو 7.2 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام السابق.
هذا التراجع لم يكن نتيجة الحرب وحدها، بل نتيجة فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل أو تأمين طرق بديلة لحماية أهم موارد البلاد من تقلبات الأوضاع الإقليمية. - التجارة الخارجية: أظهرت بيانات البنك المركزي اتساع العجز في الحساب الجاري خلال عام 2024، مع تلاشي إيرادات قناة السويس وارتفاع فاتورة الواردات لتعويض نقص الإنتاج المحلي.
وبدلاً من دعم التصنيع أو الزراعة لتقليل التبعية، واصلت الحكومة سياسة الاستيراد المفتوح التي استنزفت الاحتياطي النقدي وأضعفت الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. - السياحة: رغم تسجيل مؤشرات تعافٍ جزئي في عام 2025، فإن تقرير البنك الدولي وصف هذا التحسن بأنه "غير متوازن".
فالقطاع السياحي ما زال هشًّا، نتيجة غياب استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وتنويع الأسواق، حيث لم تتمكن الأسواق البديلة من سد الفجوة التي خلّفها تراجع الأسواق التقليدية.
سياسات الحكومة ومأزق المواطن
أمام هذه الأزمات، اختارت الحكومة أسهل الحلول وأقساها على المواطن: مزيدًا من الاقتراض، وبيع الأصول، وتقليص الدعم.
فبحسب الخبير خزيم، أدى تراجع إيرادات القناة وارتفاع فاتورة الواردات إلى تفاقم حاجة الدولة للدولار، مما دفعها إلى التوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي.
ورغم الإعلان عن قفزة في صافي الأصول الأجنبية بنحو 4.9 مليار دولار في مارس 2025، فإن الدين العام ما زال عند مستويات خطيرة، فيما لا يشعر المواطن بأي تحسن فعلي في حياته اليومية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن “إصلاح مالي”، كانت النتيجة خصخصة متسارعة لأصول الدولة وعقد شراكات تفضيلية مع دول الخليج لشراء ممتلكات مصرية مقابل ديون متراكمة.
هذا المسار كشف عن تحول الدولة إلى بائع مضطر لا إلى شريك اقتصادي قادر.
وفي المقابل، تم تقليص الإنفاق الاستثماري على الصناعة والزراعة، ما يعني تجميد أي فرص حقيقية للنمو المستدام.
هذه الإجراءات، التي جاءت تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، فرضت خفض الدعم عن السلع الأساسية والطاقة والكهرباء، فأصبح المواطن في مواجهة مباشرة مع تضخم مستمر، رغم التطمينات الرسمية بانخفاضه.
النتيجة أن المصريين يدفعون اليوم ثمن “الإصلاح” من قوتهم اليومي، بينما تحافظ الحكومة على بنية اقتصادية ريعية تخدم النخبة والديون لا المجتمع والإنتاج.
مفارقة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل
في خضم الأزمة، تبرز مفارقة صارخة: فبينما يعاني المواطن من الغلاء ونقص السيولة، تعزز الحكومة تعاونها الاقتصادي مع إسرائيل.
فقد أبرمت صفقة بقيمة 35 مليار دولار لمضاعفة واردات الغاز من الحقول الواقعة في المياه المحتلة لتصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول صيف 2026 — وهي خطوة تُظهر ارتهان القرار الاقتصادي المصري للاعتبارات السياسية، لا للمصلحة الوطنية.
في الوقت نفسه، رفعت 38 شركة مصرية صادراتها إلى إسرائيل لتشمل مواد بناء وسلعًا غذائية، فيما زادت واردات مستلزمات الإنتاج لمصانع النسيج ضمن اتفاقية "الكويز" التي تمنح امتيازات للسوق الأمريكية، ما يعني أن العلاقات التجارية مع الاحتلال تشهد ازدهارًا في الوقت الذي تتراجع فيه القطاعات المنتجة محليًا.
أزمة بنيوية لا تنتهي
بعد عامين من الضغوط المتراكمة، يخرج الاقتصاد المصري منهكًا ومثقلًا بالديون، وأكثر اعتمادًا على التمويل الخارجي وبيع الأصول.
ورغم محاولات التجميل الرسمية بالحديث عن "الانتعاش المرتقب"، تبقى الحقيقة أن غياب العدالة في توزيع الأعباء، واستمرار إدارة الاقتصاد بعقلية الجباية والاقتراض، يبددان أي فرصة لنمو مستدام أو تنمية حقيقية.
فبينما تتعلق الحكومة بأمل “الاستقرار الإقليمي”، يظل السؤال مفتوحًا: هل يمكن لنظام اقتصادي يقوم على الديون والولاءات أن يحقق نموًا حقيقيًا لمواطنيه؟