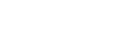تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة حالة غضب بين مصريين مقيمين في دول عدة، بعد اشتراط ما يُعرف بـ“الموافقة الأمنية” لتجديد جوازات السفر وإنهاء معاملات قنصلية. متضررون يقولون إن الإجراء لا يوقف ورقة فقط، بل يهدد الاستقرار القانوني والمهني في بلد الإقامة. الملف يعود إلى الواجهة في لحظة حساسة، لأن تقديرات رسمية تتحدث عن نحو 14 مليون مصري خارج البلاد، وتحويلاتهم تُعد من أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية سنويًا.
جواز السفر كحق قانوني… و”المراجعة الأمنية” كعائق عملي
بحسب متابعين للملف، تقوم “الموافقة الأمنية” على مراجعة بيانات طالب الخدمة القنصلية وموقفه القانوني قبل إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية. هذه الصياغة تبدو إدارية، لكنها في التطبيق تتحول إلى نقطة تحكم كاملة في حق أساسي. الجواز ليس خدمة اختيارية، بل وثيقة هوية وسفر وإقامة. وأي تعطيل فيها يضع المواطن في منطقة رمادية أمام سلطات بلد الإقامة، حتى لو كان ملتزمًا بكل القوانين المحلية.
يرى المحامي الحقوقي خالد علي أن ربط استخراج وثائق الهوية بموافقة أمنية غير محددة المعايير يحوّل الحق إلى منحة، ويجعل المواطن تحت رحمة قرار غير قابل للتوقع. ويشير إلى أن أي إجراء يمس الجواز يجب أن يكون محكومًا بقواعد مكتوبة، ومواعيد واضحة، وإتاحة تظلم فعال. غياب ذلك يخلق بابًا للتعسف، حتى لو قُدّم الإجراء بوصفه “تنظيمًا” أو “تدقيقًا” إداريًا.
حقوقيون يرون أن الإجراء تجاوز الإطار الإداري ليصبح، في بعض الحالات، أداة ضغط سياسي، خاصة بحق معارضين أو نشطاء مقيمين بالخارج منذ 2014. هذه النقطة لا تتعلق بنقاش سياسي مجرد، بل بآثار ملموسة. عندما تتوقف معاملة قنصلية دون تفسير، يصبح المواطن أمام مخاطر تتصل بالإقامة والعمل والسفر. ويصبح الصمت السياسي، في نظر بعض الأسر، شرطًا ضمنيًا لتأمين أبسط أوراق الحياة.
تعطيل الوثائق ليس “تأخيرًا”… بل فقدان إقامة وعمل وخدمات أساسية
منظمة كانت قد وثقت في تقارير سابقة حالات رفض أو تعطيل إصدار وثائق رسمية لمعارضين وصحفيين. واعتبرت أن ذلك يقيّد قدرتهم على الإقامة والعمل والسفر بصورة قانونية، ويعرض أسرهم لمخاطر قانونية وإنسانية. خطورة هذا التوثيق أنه ينقل المشكلة من شكاوى فردية إلى نمط قابل للرصد. وهو ما يرفع سقف المساءلة عن معيار التعطيل، ومدته، وسبل مراجعته.
تحذر تقارير حقوقية من أن تعذر تجديد جواز السفر أو استخراج شهادات الميلاد والتوكيلات لا يعني تأخيرًا إداريًا بسيطًا. بل قد يؤدي إلى فقدان الإقامة أو الوظيفة. وقد يفتح نزاعًا قانونيًا في بلد الإقامة بسبب انتهاء صلاحية الوثائق. وقد ينعكس على الأسرة كاملة، لأن معاملات التعليم والرعاية الصحية والتمثيل القانوني تحتاج أوراقًا سارية، لا وعودًا قنصلية غير محددة.
يرى الحقوقي حسام بهجت أن أخطر ما في هذه الممارسات هو أنها تدفع مواطنًا ملتزمًا بالقانون إلى وضع “غير نظامي” قسرًا، ثم تُترك تبعاته عليه وحده. ويشير إلى أن الدولة هنا لا تكتفي بخصومة سياسية مع أفراد، بل تخلق ضررًا ممتدًا لأطفال وزوجات وأسر، عبر أدوات وثائقية. ويضيف أن أي قيود على وثائق الهوية يجب أن تخضع لضمانات قانونية صارمة، لأن الضرر الناتج عنها سريع وواسع ولا يمكن احتواؤه بسهولة.
الغضب بين الجاليات لا يتغذى فقط من الإجراء، بل من الغموض المحيط به. لا توجد توضيحات رسمية مفصلة تشرح معايير تطبيق “الموافقة الأمنية” أو نطاقها. هذا الفراغ يفتح الباب لتقديرات متباينة ويزيد القلق. خصوصًا في دول ترتبط فيها الإقامة والعمل مباشرة بصلاحية الوثائق. في هذه البيئة، يصبح عدم اليقين بحد ذاته أزمة، لأن الناس تحتاج جدولًا، لا انتظارًا مفتوحًا.
تحويلات بالمليارات ورسائل متناقضة: الدولة تريد الدولار وتضغط بالوثائق
اقتصاديًا، تمثل تحويلات المصريين بالخارج شريانًا حيويًا للاقتصاد، خاصة في أوقات الأزمات ونقص النقد الأجنبي. لذلك يرى محللون أن تشديد الإجراءات القنصلية يبعث برسالة سلبية إلى جالية تعتمد عليها الدولة في دعم ميزان المدفوعات. الرسالة تصبح أكثر حدة عندما تُقارن بين خطاب رسمي يدعو للاستثمار والتحويل عبر القنوات الرسمية، وبين ممارسة قد تهدد الاستقرار القانوني لمن يُطلب منه التحويل.
يتساءل مراقبون عن كيفية الجمع بين تشجيع المصريين بالخارج على ضخ مدخراتهم، وبين إجراءات يراها كثيرون تضييقًا قد يعرضهم لفقدان أعمالهم أو إقاماتهم. السؤال ليس أخلاقيًا فقط. هو سؤال مصلحة مباشرة. لأن الثقة شرط للتحويلات المنتظمة. وأي شعور بأن الوثائق يمكن أن تتحول إلى أداة ضغط يخلق حافزًا للتباعد، أو لتقليل الارتباط المؤسسي، أو لتجنب الاحتكاك القنصلي قدر الإمكان.
يرى الاقتصادي مراد علي أن الإضرار بثقة الجاليات يحمل كلفة مالية غير معلنة. التحويلات لا تتحرك بالعاطفة فقط، بل بالطمأنينة المؤسسية. وعندما يشعر شخص أن تجديد جوازه قد يتعطل لأسباب غير مفهومة، سيتعامل مع الدولة باعتبارها مخاطرة. ويضيف أن الدولة التي تريد عملة أجنبية مستقرة تحتاج سياسة قنصلية مستقرة، لأن الاستقرار القانوني للمغترب جزء من “الأمن الاقتصادي” نفسه.
في قلب الجدل يبرز سؤال شديد الحساسية: هل تُغلّب الدولة اعتبارات الأمن السياسي على الأمن المعيشي لملايين المواطنين في الخارج؟ طرح السؤال هنا ليس ترفًا. لأن الخدمات القنصلية هي الحد الأدنى من علاقة الدولة بمواطنيها خارج الحدود. وعندما تُربط هذه الخدمات بإجراءات غير شفافة، يصبح المواطن أمام معادلة قاسية بين التعبير عن رأيه وضمان أوراقه، حتى لو كان يعيش بعيدًا عن المجال السياسي منذ سنوات.
نقطة النهاية في هذا الملف واضحة: جواز السفر وثيقة هوية وحق قانوني، وليس امتيازًا مؤقتًا. ومع اتساع دائرة النقاش، يبدو أن القضية تجاوزت البعد الإداري لتلامس حدود العلاقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج. كما تلامس حدود الكلفة السياسية والاقتصادية لأي تضييق، قد يمتد أثره إلى الداخل قبل الخارج، عبر الثقة والتحويلات والاستقرار الاجتماعي لعائلات موزعة بين بلدين.