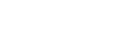في توقيت بالغ الحساسية، استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي المقررَ الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، بيدرو أروخو أجودو، بالتزامن مع زيارة أممية لمصر تمتد من 8 إلى 17 فبراير 2026.
الرسالة الرسمية كانت واضحة: مصر “تواجه ندرة مائية” وضغوطًا خارجية، بينما تتحرك الدولة عبر التحلية وإعادة الاستخدام وتطوير الشبكات. لكن خلف هذا السرد المنمّق، تقف أرقام صلبة لا تُجمَّل بالبيانات: نصيب الفرد انخفض لأقل من 490 مترًا مكعبًا سنويًا، ومصر تعتمد على النيل بنسبة 98% لتوفير المياه لأكثر من 110 مليون مواطن في ظل اعتماد شبه كامل على مصدر واحد.
والسؤال الذي تفرضه الزيارة الأممية ليس: “كيف نربح نقطة دبلوماسية؟” بل: لماذا ما زال المواطن يدفع ثمن أزمة تُدار بعقلية ردّ الفعل، بينما تُترك الاختلالات الداخلية تتراكم حتى تصبح “طبيعية”؟
زيارة أممية.. اختبار للشفافية لا لالتقاط الصور
هذه الزيارة ليست مجرد لقاءات بروتوكولية. جوهرها سياسي وحقوقي في الوقت نفسه، لأن الأمم المتحدة حين تتحدث عن “الحق في المياه” لا تقيسه بعدد المشروعات التي تُعلنها الحكومات أو حجم البيانات التي تُصدرها، بل تقيسه بما يصل فعليًا للناس: هل المياه متاحة باستمرار أم تنقطع؟ هل هي آمنة أم مشكوك في جودتها؟ هل يحصل عليها الجميع بعدالة أم أن الريف والمناطق الأفقر يدفعون كلفة أعلى مقابل خدمة أضعف؟ وهل تكلفة المياه والصرف يمكن تحمّلها أم تتحول لعبء إضافي على الأسر؟
هنا تحديدًا تصبح المشكلة محرجة للخطاب الرسمي، لأن لغة الحقوق لا تقبل التهرب. فإذا كانت الدولة تريد تحويل الزيارة إلى منصة لتدويل أزمة سد النهضة فقط، فهي تتعامل مع نصف الحقيقة. النصف الآخر داخلي: حوكمة وإدارة وبنية تحتية وأولويات واستجابة للأزمات، وكلها تُقاس بنتائج ملموسة لا بشعارات.
النيل شماعة سهلة.. لكن الهدر والزراعة يكشفان عمق الأزمة
لا جدال أن ملف سد النهضة عامل ضغط حقيقي وأن إجراءات دول المنبع قد تزيد المخاطر، لكن اختزال الأزمة في الخارج وحده هو أسهل حيلة سياسية: شماعة تُبعد المسؤولية عن الداخل. فالمشهد الداخلي يحمل أسبابًا ثقيلة لا يمكن القفز فوقها: طلب مائي متضخم، استهلاك زراعي واسع، وهدر كبير بسبب شبكات متقادمة وإدارة فاقد غير محسومة.
الزراعة تظل أكبر مستهلك للمياه في مصر، حيث تستحوذ على نحو 86% من إجمالي سحوبات المياه وفق تقديرات دولية سابقة. هذا الرقم وحده يفرض حقيقة مُرّة: أي خطة “جذرية” للأمن المائي لا تبدأ بالتصريحات، بل بإعادة ضبط سياسات الزراعة نفسها: ما الذي نزرعه؟ وكيف نروي؟ وكيف نربط الدعم والحوافز بكفاءة استخدام المياه بدلًا من مكافأة الإسراف؟
ثم تأتي الحلقة الأكثر استفزازًا للمواطن: الفاقد في مياه الشرب. نسبة الفاقد من المياه النقية المنتجة بلغت 25.7% في 2023/2024 وفق بيانات رسمية منشورة. ربع المياه تقريبًا يضيع بين تسريب وفقد تجاري وشبكات متهالكة… ثم يُطلب من الناس ترشيد الاستهلاك وكأن المشكلة بدأت في البيت لا في البنية الأساسية. وعندما تكون الشبكات نفسها مصدر نزيف دائم، يصبح الحديث عن “الترشيد” مجرد خطاب أخلاقي لتغطية عجز إداري، لا سياسة فعّالة لحماية مورد نادر.
تحلية باهظة.. وأولويات مشوّهة: لماذا تُسقى الرفاهية قبل القرى؟
السلطة تُكثر الحديث عن التحلية وإعادة الاستخدام باعتبارهما الحل، لكن التحلية مكلفة وتحتاج طاقة وتشغيلًا وصيانة طويلة الأجل، ولا يمكنها وحدها تعويض أي نقص كبير في تدفقات النيل إذا تفاقمت الأزمات. الأخطر أن خطاب “الندرة” يتعايش في الوقت نفسه مع قرارات تخطيط تُرسل إشارات عكسية للمجتمع: حين تُوجَّه المياه لمشروعات عمرانية واستثمارية ضخمة في الصحراء، بينما ما زالت قرى ومناطق تعاني ضعف البنية أو مشاكل الخدمة، يصبح السؤال مشروعًا: ما معيار الأولويات؟
الحق في المياه يعني ببساطة جارحة أن الأولوية ليست لتسويق مدن جديدة ولا لرفع قيمة الأرض ولا لإنتاج صور افتتاحات، بل لضمان وصول المياه الآمنة بشكل عادل ومنتظم، وتقليل الهدر أولًا، وإصلاح الشبكات قبل أي توسع يضيف طلبًا جديدًا على مورد منهك أصلًا.
وفي النهاية، زيارة المقرر الأممي يمكن أن تكون فرصة مفيدة إذا تحولت إلى مرآة للواقع لا إلى منصة دعاية: أين تتعطل الشبكات؟ أين يضيع الفاقد؟ من يدفع أكثر؟ ومن يحصل أقل؟ أما إذا اكتفت الدولة بسرد “قصة الندرة” وإلقاء اللوم على الخارج وحده، فستبقى الأزمة تتضخم حتى يصبح رقم 490 مترًا مكعبًا مجرد محطة في طريق أكثر خطورة.