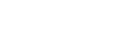يعتبر قرار تفكيك جامعة حلوان ونقلها إلى العاصمة الإدارية ليس “تطويرًا” ولا “توسعةً” بقدر ما هو تعبيرٌ فاقع عن تحوّل الدولة من مزوّدٍ للخدمة العامة إلى وسيطٍ يصفّي الأصول لصالح السيولة.
الجامعة ليست مباني فحسب؛ إنها ذاكرةٌ اجتماعية وموردٌ معرفي واقتصادٌ محليّ، ومع ذلك يُتعامل معها كقطعة أرضٍ قابلة للتسييل.
هنا يبرز السؤال: هل ما زالت الدولة ترى التعليم حقًا عامًا أم سلعةً قابلة لإعادة التغليف والتسويق؟.
من الجامعة إلى الصفقة
القضية ليست “نقلًا إداريًا”، بل تحوّل الجامعة إلى بندٍ في دفاتر الجرد: أصلٌ يُفرّغ ثم يُباع.
الدولة، التي يُفترض أنها جهة خدمية، تتصرف كقابضةٍ تبحث عن تمويل سريع بأي ثمن.
هكذا تُدار الجامعات بعقلية الجباية لا التنمية، ويُستعاض عن التمويل العام بتحميل الطلاب وأسرهم كلفة ما تهدمه السياسات.
الاستراتيجية الرسمية: ورقة لا قيمة
التعليم يُعاد تعريفه كمشروع ربحي: رسومٌ ومصروفات وشهادات وخدمات “استشارية” بلا قيمة مضافة حقيقية.
بدل إنشاء جامعة جديدة للعاصمة، يجري نزع هوية جامعة قائمة وإعادة تسميتها، وترحيل طلابها وأساتذتها لمسافة طويلة بلا دراسة جدوى معلنة، ولا مشاورةٍ مجتمعية، ولا خطة انتقال تحفظ الجودة والعدالة المكانية.
الأبعاد الخفية للقرار
ماليًّا، تُحوَّل الأصول الثابتة (أراضي الجامعات) إلى سيولة عبر التفريغ فالبيع فتمويل مشروعات واجهية أو ترقيع المؤشرات.
سياسيًّا واجتماعيًّا، يُعاد تشكيل العقد الاجتماعي: من حقٍّ عام إلى سلعة قابلة للبيع.
والنتيجة تفكيك نسيجٍ محليّ قائم حول الجامعة، وانكماش اقتصاد حلوان وفقدان آلاف فرص العمل غير المباشرة.
لماذا حلوان؟
لأنها ليست نخبوية فتكون المقاومة أضعف، ولأنها تملك مساحات ثمينة داخل نسيجٍ عمراني مكتمل، ولأن اسمها مرتبط بالمكان وقابل للفصل والتسويق.
تُختار الحلقة “الأضعف” لتُقدَّم نموذجًا يُعمّم لاحقًا على بقية المؤسسات، فيتحوّل الاستثناء إلى قاعدة.
ثغرة “الفرع”: إغلاق مقنّع
الترويج لتحويل الموقع التاريخي إلى “فرع” يُخفي مسار إغلاقٍ تدريجي.
الفرع تابعٌ إداريًّا وماليًّا للمركز الجديد، فتتجه الاستثمارات والكوادر والبرامج نحو العاصمة على حساب حلوان.
وحتى المفارقة الرقمية المتداولة تعرّي الخطاب: موقع حلوان الأكبر (يُقال إنه نحو 400 فدان) مقابل موقعٍ أصغر في الصحراء (نحو 150 فدانًا).
كيف يكون “الفرع” أكبر من “الأصل”؟ المنطقي أن المقصود تفريغ الكبير وشرعنة بيعه.
من يدفع الفاتورة؟
الطلاب سيدفعون زمنًا ومالًا وانقطاعًا، والأسر تتحمّل سكنًا ونقلًا أثقل، وأعضاء هيئة التدريس تحت ضغط التشتت وانهيار بيئات البحث.
الجودة تتآكل حين تتبدّد المختبرات والشبكات الأكاديمية وتُدار جامعةٌ واحدة على موقعين متباعدين. هذه ليست “خدمة لسكان العاصمة الجديدة”، بل خدمةٌ لأسواق العقار على حساب العدالة التعليمية.
ثغرة الشرعية وتعديل القانون
الالتفاف القانوني عبر تعديل أحكام تنظيم الجامعات بدل إنشاء كيانٍ مستقل يكشف جوهر العملية: نقل الهوية لا إنشاء هوية.
هكذا يُمنح التفكيك غطاءً قانونيًّا يقي من الطعن القضائي، لكنه يفتح سابقة خطيرة تُسهّل تكرار السيناريو مع مؤسساتٍ أخرى وتحويل الملكية الشعبية إلى أوراقِ صفقة.
نمطٌ يتكرّر منذ 2014
الفلسفة نفسها: فكّ المؤسسة، بيع الأرض، بناء واجهة جديدة “لمن يدفع”.
نُقلت السجون إلى الصحراء، أُفرغت الوزارات من قلب العاصمة التاريخي، وأُهملت المستشفيات المركزية لصالح مشاريع خاصة.
جامعة حلوان حلقةٌ في سلسلة تآكل الملكية العامة تحت عناوين زائفة.
البديل الممكن
الإصلاح الحقيقي يبدأ بتطوير حلوان في موقعها عبر شراكاتٍ صناعية وبرامج تطبيقية وجامعةٍ ذكية متجذّرة في بيئتها، وفتح فرعٍ بحثي صغير في العاصمة بدل اقتلاع المؤسسة.
ويمكن—بشفافية كاملة—توظيف جزءٍ محدود من الأرض لتمويل المنح والمختبرات والسكن الطلابي، لا لتمويل واجهاتٍ صحراوية.
وختاما فما يحدث لجامعة حلوان اختبارٌ لطبيعة الدولة: هل هي دولةُ خدمةٍ تحمي الحق العام أم دولةُ جبايةٍ تتصرّف في الوطن كأصلٍ للبيع؟
استمرار هذا المنطق يعني بيع الذاكرة قطعةً قطعة تحت أسماء برّاقة، على حساب أجيال تُحرَم من تعليمٍ عام كريم.
إيقاف التفكيك الآن ليس دفاعًا عن مبانٍ، بل عن معنى الجامعة والدولة والملكية العامة.