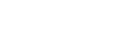في واحدة من أكثر المشاهد تعبيرًا عن ارتباك الخطاب الرسمي المصري وتناقضه، أقدمت الهيئة العامة للاستعلامات على خطوة أثارت الريبة: إصدار بيان قوي اللهجة بشأن الوجود العسكري في سيناء، ثم مسحه سريعًا وإصدار نسخة جديدة مخففة، تكاد تكون ناعمة في لغتها، وكأن الهدف هو امتصاص الغضب من جانب، وعدم إغضاب تل أبيب وواشنطن من جانب آخر. المفارقة ليست في مجرد تعديل البيان، بل في الكشف عن طبيعة إدارة الملف المصري – الإسرائيلي: كل ما يُقال في العلن ضد إسرائيل ليس إلا عرضًا متفقًا عليه مسبقًا، بينما على الأرض تسير الترتيبات في انسجام مع تل أبيب.
البيان الأول: لهجة عسكرية صارمة
البيان المحذوف للهيئة كان واضحًا وحادًا:
تأكيد أن وجود الجيش المصري في سيناء قرار سيادي بحت يخضع لاعتبارات الأمن القومي المصري وحدها.
الإشارة إلى أن القوات المسلحة تتصرف في كل الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة لحماية حدود البلاد دون الرجوع إلى أي طرف.
وصف الحرب الجارية في غزة بأنها حرب إبادة شرسة تستدعي يقظة وتأهبًا كاملين على الحدود الشرقية.
هذه اللغة حملت رسائل سياسية مهمة: أن مصر ترى نفسها في مواجهة مباشرة مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، وأن الجيش المصري مستعد للتحرك من منطلق حقه الكامل في السيادة. لكن سرعان ما اختفى هذا البيان، وكأن "شدة اللهجة" كانت أكبر من المسموح به.
البيان الثاني: نسخة مخففة للهضم
النسخة المعدلة التي صدرت لاحقًا جاءت بلغة أكثر هدوءًا، بل أقرب إلى التبرير:
التواجد العسكري في سيناء هدفه الأساسي "تأمين الحدود ضد الإرهاب والتهريب".
كل ذلك يتم "في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام".
تأكيد حرص مصر على عدم خرق أي اتفاقية دولية وعلى استمرار معاهدة السلام.
هكذا تحوّل خطاب القوة والسيادة في البيان الأول إلى خطاب "الحرص والالتزام" في النسخة الثانية. وكأن الهدف إرسال رسائل تطمينية إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن مصر لا تتجاوز الخطوط المرسومة في كامب ديفيد، وأن أي تحرك عسكري مصري في سيناء يظل تحت سقف الملاحق الأمنية للمعاهدة، لا خارجها.
لماذا المسح والتعديل؟
التراجع السريع يثير سؤالًا جوهريًا: لماذا أُزيل البيان الأول؟
ضغط خارجي مباشر: من الواضح أن اللغة الصدامية لم ترق لإسرائيل أو واشنطن، فتم سحب البيان.
خوف داخلي من التصعيد: الدولة المصرية لا تريد أن تُفهم رسائلها كإعلان تحدٍّ أو استعداد لمواجهة.
إدارة مزدوجة للرأي العام: تقديم خطاب "وطني" أولًا لامتصاص غضب الشارع، ثم استبداله بخطاب "ديبلوماسي" يُرضي الأطراف الدولية.
هذا السلوك يكشف أن ما يُقال في البيانات ليس انعكاسًا حقيقيًا لسياسة الدولة، بل مجرد مسرحيات علاقات عامة.
شو سياسي متفق عليه
القاهرة تدرك أن إسرائيل تعلم جيدًا حدود التواجد العسكري المصري في سيناء، وكل ما يُبنى من منشآت أو قواعد يجري بالتنسيق الفعلي، حتى لو لم يُعلن ذلك. ومع ذلك، تصر الدولة المصرية على لعب دور "المُعارض اللفظي": بيانات، تصريحات، وخطوط حمراء. لكن الحقيقة أن هذه الخطوط تُرسم وتُدار بالتفاهم المسبق مع تل أبيب وواشنطن.
كل ما يُقال عن رفض التهجير، وعن "الحرب البربرية" في غزة، لا يتجاوز شو إعلامي محسوب بدقة. الهدف مزدوج:
تقديم صورة "مصر القوية" للشعب الذي يغلي من مشاهد الإبادة في غزة.
وفي الوقت نفسه طمأنة إسرائيل بأن هذا مجرد كلام استهلاكي لا يترتب عليه تغيير في السياسات أو التحركات العسكرية.
ازدواجية الخطاب الرسمي
ما يؤكد هذه الازدواجية هو أن الهيئة العامة للاستعلامات – بوصفها ذراعًا إعلامية للدولة – لم تشرح أسباب تعديل البيان أو حذفه، ولم تعتذر حتى عن "الخطأ". ببساطة، اعتبرت أن الشعب لن ينتبه، أو أنه سينشغل بالقضية الفلسطينية أكثر من التدقيق في لهجة البيانات. لكن هذه السياسة القائمة على التلاعب بالكلمات تكشف أن النظام المصري يخشى قول الحقيقة الكاملة: أن كل تحرك في سيناء يظل مربوطًا بقرار إسرائيلي–أمريكي، مهما غُلّف بشعارات السيادة.
إسقاطات سياسية
الأمن القومي المصري بات يُدار بميزان دقيق يخضع أكثر للمعاهدة مع إسرائيل من أي اعتبارات داخلية.
موقف مصر من غزة، رغم ما يقال إعلاميًا، لا يتجاوز حدود التنسيق المسبق. رفض التهجير هو موقف مُعلن، لكن لا أحد يعرف حجم التفاهمات السرية خلف الكواليس.
العلاقة المصرية–الإسرائيلية تعيش حالة "فتور علني" لكنها في الواقع قائمة على تنسيق أمني عميق، وهو ما يفسر لماذا يجرؤ نتنياهو على مهاجمة مصر علنًا بينما تستمر اللقاءات السرية في مستويات مختلفة.
وفي ضوء ما سبق فإن مسح بيان الهيئة العامة للاستعلامات وإعادة صياغته بلغة مخففة لم يكن مجرد خطأ بروتوكولي أو ارتباك لحظي، بل هو دليل على طبيعة اللعبة السياسية في مصر: كل ما يُقال ضد إسرائيل في العلن ليس سوى شو متفق عليه مسبقًا، لإرضاء الرأي العام وامتصاص الغضب الشعبي، بينما على الأرض تظل العلاقات الأمنية والعسكرية محكومة بالتنسيق العميق مع تل أبيب وواشنطن. ما جرى يكشف أن السيادة الوطنية تُدار بمنطق "ما يُقال شيء، وما يُفعل شيء آخر"، وأن بيانات الدولة ليست سوى نصوص مسرحية تُكتب على مقاس اللحظة السياسية، لا على مقاس الحقيقة.