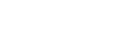بقلم: جودي الأسمر
يقترن باضطراب الشرق الأوسط اضطرابٌ موازٍ في المعلومات، ويغذّي أحدُهما الآخر في حلقة مفرغة. نجح هذا الترابط في رهن الجماهير في العالم لروايات كاذبة، منحازة أو مضلّلة، عوضاً من أن تبلغ حقّها الطبيعي في الوصول إلى الحقيقة. ومع الإقرار بخطورة هذا الاضطراب في الوقت الحاضر، إنّما أثره يبلغ مستوياتٍ غير قابلة للاسترداد عند التفكير في المستقبل؛ حين تتفشّى اليوم الاضطرابات المعلوماتية، فإنها حتماً ستورّث إجابةً مجتزأة، وغير دقيقة، عن سؤال مصيري ستطرحه الأجيال القادمة: كيف وصل الشرق الأوسط إلى هنا؟
من ناحية ثانية، لا ضمانات لعدم وقوع انهيار مفاجئ في التوثيق الرقمي للأحداث، سواء بفعل استهداف ممنهج أو انهيار تقني، الأمر الذي يُنتِج فراغات لا تُعوَّض داخل الرواية المستقبَلة لمراحل مفصلية في تاريخ المنطقة. وقد حفلت السنتان الأخيرتان بدلالات واضحة، خصوصاً خلال الحروب التي خاضتها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة. ولم تنشب هذه الحروب في توقيتٍ عشوائي، بل بعد بناءٍ دؤوبٍ ومدروسٍ لقدرة إسرائيل على التحكّم في البنية الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي. يمكّن هذا التمركز القوى المسيطرة من صياغة السرديات التاريخية وتوجيه الوعي الجمعي المقبل بما يخدم مصالحها. كما تمكّنها هذه السلطة السرديّة من قلب ميزان العدالة بين الظالم والمظلوم، وهي المتمرّسة في تحوير معنى الظلم التاريخي، والذي طوّرت من خلاله أداة عليا للقمع عنوانها "معاداة السامية".
ورغم أهمية الملف النووي وتجلياته في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية أخيراً، ورغم تجاهل وسائل الإعلام الحرب الجارية في السودان والانقطاعات الكاملة المتكرّرة للإنترنت هناك، وقبلها الحظر الرقمي في سورية، في ظلّ نظام بشار الأسد، تظلّ غزّة البوصلة التي أعادت صياغة أخلاقيات الخبر، بحيث أطيحت من دون روادع أو وجود نظم محاسبة جدّية كان من شأنها أن توقف هذا المدّ من الكذب والتضليل. لا نفشي سراً في بعض الأمثلة:
• الاغتيال المتعمّد للصحافيين في غزّة، وعددهم 228 صحافياً حتى مطلع يوليو/ تموز الجاري، وقد تيسّر الوصول إلى كثيرين منهم من خلال أدوات وبرامج مختلفة للذكاء الاصطناعي.
• استمرار قائمة "كناري ميشن" في التربّص بالأصوات الأكاديمية والصحافية المتضامنة مع الفلسطينيين، وقمعها، وقدح سمعتها المهنية، خصوصاً في أميركا الشمالية.
• استبعاد السرديات البديلة حول عملية طوفان الأقصى وتبعاتها من وسائل الإعلام الغربية الكبرى، وكذلك من منصّات عربية.
• الإنكار الاسرائيلي الرسمي المتكرّر لجرائم الحرب، منها استخدام الفوسفور الأبيض في غزّة، مشفوع بحملات التضليل الإعلامي، أمثال "باليوود" إلى "غزّة وود"، التي تعيد تدوير الرواية الرسمية وتنكر الجرائم المرتكبة. وكان جديدها أخيراً، حتى تاريخ كتابة المقال، دسّ الأوكسيكودون، وهو نوع من الأفيون الصناعي فائق الإدمانية، داخل أكياس الطحين الموزّعة في غزّة عبر مراكز المساعدات التي يديرها جيش الاحتلال، ووصفتها أوساط حقوقية بسلاح إبادة جماعية ناعم.
و"الإبادة" هنا ليست توصيفاً منفرداً. فمنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (2023)، يختبر العالم المعاصر معنى غير مسبوق للحرب، إذ لم تعد صراعاً من أجل البقاء، بل محاولات منظمة لممارسة المحو. والمحو في قصة غزّة فعلٌ مركّب يشمل الإنسان، والخبر، وناقلي الخبر.
تؤكّد هذا السياق أرقام "مجتمع التحقّق العربي" في تقريره الصادر في الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، وهو الأول من نوعه، ويتناول 5402 مادّة تحقّق فنّدتها 23 منصة تدقيق معلومات، وقد كشفت تصدّر الموضوعات السياسية بؤرة اضطراب المعلومات بنسبة 72% من المواد، وصنّفت 90% منها "غير صحيح". وأضاف التقرير أنّ "الحرب على غزّة" تصدّرت مشهد التضليل، متقدّمة على سائر العناوين الأخرى العالمية.
في الوقت نفسه، تواجه المبادرات العربية لتدقيق المعلومات واقعاً شبه تعجيزي، إذ تعيق محدودية الموارد المالية والتقنية والبشرية تتبّع الكم الهائل والوتيرة المتسارعة لانتشار المعلومات الخاطئة والمضلّلة، والأكثر استعصاء يطرحه التزييف العميق. ناهيك عن العجز في الوصول إلى الجمهور الإسرائيلي والغربي، بلغاتهم وثقافتهم المختلفة، كما أن هؤلاء الصحافيين والخبراء ينطلقون من الأخبار الخاطئة ليصحّحوها، لا من خلال رواية أصيلة متكاملة يصيغونها ويحفظونها.
وكثيراً ما يصطدم المدوّنون وصانعو المحتوى الداعمون للشعب الفلسطينيّ في غزّة بـ"معايير المجتمع"، التي تحجب المضامين عن الإبادة الجارية، وتتعامى عنها، فيُحظر محتواهم أو تغلق حساباتهم. وفي إدراك لهذا المشهد، وإدراك لعدم القدرة على التصدي له، لم يكن مفاجئاً انسحاب مؤسسة "أريج" (إعلاميون من أجل صحافة عربية استقصائية) أخيراً بقرار منها، من منصّتي فيسبوك وإكس، بعد منشور أخير جاء فيه "نحن نحوّل تركيزنا نحو منصّات وأدوات تتوافق بشكل أفضل مع قيمنا، حيث يمكننا بناء مجتمع حقيقي، وإعطاء الأولوية للسلامة والشمول، والتفاعل مع جمهورنا من دون المساومة على مبادئنا".
هشاشة النظام الرقمي
يعكس الوجه الآخر من المشهد مفارقةً مقلقةً وإيجابيةً في آن، إن أحسن استثمارها، فالنمط الراهن الذي يقدّم المنصّات الرقمية قوىً قاهرةً ومطلقةً، لا ينطبق على مستوى الحصانة التقنية، بمعنى أنّه لا يمكن الجزم بأن شركات التكنولوجيا الكبرى عصيّة على الاختراق أو الانهيار. رغم ما تعلنه "ميتا"، و"إكس"، و"غوغل"، و"OpenAI" وتفرّعاتها من اعتماد أنظمة أمان متقدمة كالتشفير، والمراقبة المستمرة، وجدران الحماية، وأنظمة كشف التسلل، يشهد العالم باستمرار، وخاصّة في مناطق النزاعات، تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستخدم في الطيران والملاحة وصور الأقمار الصناعية. وفي وقت سابق غير حافل بالحروب، توقّف "فيسبوك" في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أكثر من ستّ ساعات نتيجة خطأ في إعدادات الشبكة.
هذه الحوادث، وإن بدت عرضية، كافية لإثبات أنّ الأنظمة الرقمية أقلّ من أن توصف بأنها منيعة، مع أنها تتحكّم عملياً في الذاكرة الرقمية العالمية. واستتباعاً، لن تمنع هذه الأنظمة الخيال البشري من تصوّر أو حتى ارتكاب فعل التدمير الرقمي، مادياً أو افتراضياً. ففي عالمٍ بات اللاعقلاني فيه احتمالاً واقعياً، ما الذي يمنع استهداف وادي السيليكون نفسه؟
وسط كلّ هذه الحقائق وتصوّراتها غير الباعثة للأمان، يبدو الشرق الأوسط، والشعوب العربية تحديداً، الأكثر هشاشة في تملّك ذاكرة الحروب، وأرشفتها، وحفظها من المحو.
لا حلّ ناجزاً لما يمكن تسميته "معضلة معرفيّة" يغرق بها العالم عاجلاً وآجلاً. بل أكثر من ذلك، تتّجه كل المجتمعات إلى التسابق لاكتساب المعرفة الرقمية وتعلّم تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تتسابق الدول الكبرى والموائل التكنولوجية لابتكارها، في صورة معبّرة عن استجابة جماعية وفرديّة للمقولة: "الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الإنسان، ولكنّه سيستبدل إنساناً لا يحسن استخدامه". ومع ما تحمله هذه المعادلة من حكمة لا داعي لإثباتها، إلّا أنها تضمر نفياً لوجود أي بدائل من الذكاء الاصطناعي، ومزيداً من الاعتمادية عليه، كأنّ لا حقيقة سواه أو عبره.
ذاكرة غير رقميّة
لعلّ التفكير خارج الصندوق لم يعد كامناً في التحكّم بالذكاء الاصطناعي والتنافس في تطويره، إنما في تصميم "خطة ب" يمكنها التصدي لنقاط ضعف الآلة الرقمية وتهديداتها. وقد يكون تحرير التوثيق من الفضاء الرقميّ خطوة جديرة بالاعتبار، أي اعتماد منظومة أرشيفية غير رقمية. فمع احتمال "الإبادة الرقمية" التراكمية أو المباغتة، تبدو العودة إلى التوثيق الورقي أو التدوين المطبوع خطةً استراتيجيةً آمنةً لمقاومة المحو وتحصين الذاكرة الإنسانية لشعوب المنطقة، خاصّة أنّ تفاوتاً علميّاً واسعاً ومزمناً في علوم التكنولوجيا والبيانات يفصل بين العرب وإسرائيل.
وقد تجسّد الكتابة فعلاً غير مبتكر، ولكنه سيصنع علامة فارقة في التصدي للاضطراب المعلوماتي، الآن وغداً: لا يمكن حذف التدوين المكتوب بكبسة زرّ، ولا شركة ستمنعه، ولا خوارزمية ستخفيه. كما أن الكتاب يحفظ في مكتبة، أو درج، ويمكن اكتشافه حتى بعد قرون، فضلاً عن أن التوثيق في كتاب يعدّ مصدراً أكثر موثوقية لدى الباحثين وفي الأرشفة الرسمية. والتدوين على الورق لا يمكن أن يخضع لتصنيف تلقائي "محتوى حسّاس"، أو حجبه عن محركات البحث، ولا يخضع الورق إلى "ترحيل بيانات" مثلما يحدث في المواقع والأرشيفات الإخبارية، حيث يعجز متصفّحو الإنترنت عن الوصول إلى مقال نشر على موقع إلكتروني لأنه خضع للتحديث ورُحّلت بياناته، وهناك مواقع إلكترونيّة تختفي لأنّها لم تعد تشغل مجالاً رقمياً.
تتبلور العودة إلى التدوين الورقي للأحداث فعل مقاومة استشرافياً، يعلن تحدّي الشعوب العربية لطمس الذاكرة، ويحمي الحقيقة من الزوال الرقمي
ما تقدّم جدير بأن يعيد توجيه أولويات المنطقة في دعم العلوم الإنسانية والفنون، وتشكيل جبهات توثيق علنية وسرية بين نشطاء وكتاب، على أن تكون يدويّة، وبإمكانها أن تكون عابرة للحدود. كما يجدُر تشجيع الضحايا وشهود هذه الحروب والإبادات على كتابة يومياتهم بخط اليد، أو مطبوعة، ولطالما شكّلت هذه المرويات مصدراً أساسياً لفهم فظائع الحروب عبر التاريخ. يحضر هنا الروائي اللبناني الراحل إلياس خوري، في محاضرة له في بيروت، في مايو/ أيار 2022، تحت عنوان "الرواية بعد الحرب"، فلاحظ أنّ السجل الأدبي اللبناني، خصوصاً الرواية، يفتقر لتأريخ أزمات وحروب عديدة عاشها لبنان ولا يزال منذ بداية الحرب العالمية الأولى. وما ينطبق على لبنان ينسحب منذ عقود على المنطقة العربية.
وفي وقت سابق من القرن العشرين، شهدت سياقات التحولات الكبرى، عبر الحروب أو الثورات العالمية، تناقل المجلات الصغيرة المهرّبة عبر الحدود المعروفة (أو الـZines)، ويمكنها أن تستعاد على شكل صحف دورية أو حتى روايات للشعوب. وأي فيديو هام أو صورة أو تقرير تنشره المنصات الإعلامية البديلة، يمكن مرافقته بنصوص توضيحية وتخزينه في أماكن عدّة.
خاتمة
كلّ حرب ستنتهي يوماً ما، لكن الإبادة الرقمية لا تنتهي، بل تعيد تشكيل وعي الأجيال. وإن لم تُحفظ الذاكرة الحقيقية، ستبقى رواية الغد بيد من يستحكم بها، لا من عاناها. هنا، تتبلور العودة إلى التدوين الورقي للأحداث فعل مقاومة استشرافياً، يعلن تحدّي الشعوب العربية لطمس الذاكرة، ويحمي الحقيقة من الزوال الرقمي. مع التسليم بأنّ الصحافة الورقيّة أعلنت استسلامها، يفتقر المستقبل إلى "أرشيفات ورقية ضد النسيان"، تُكتب من قلب عواصف المنطقة العربية، وتنجو لتحكي الرواية الحقيقية حين تكذب الخوارزميات، أو تصمت إلى الأبد.
ملحوظة: بعد إرساله للتحرير ونشره، ستقوم كاتبة هذا المقال بطباعته وتخبئته في مكان آمن، لأنّ الفكرة تكتمل بالفعل، ولا يلدغ صحافيّ من جحره مرّتين، فقد فُقدت مقالات سابقة نشرَتها الكاتبة لأسباب تناولها هذا النص نفسه: ترحيل بيانات، اختفاء مواقع، تغيّر السياسات، حظر منصّات.