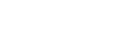لم تعد الجرائم الأسرية في مصر حوادث شاذة أو استثناءات تُروى على الهامش، بل صارت عنوانًا لواقع اجتماعي مضطرب، تُنتهك فيه قدسية البيت، ويتحوّل فيه الزوج والأب والأم والأخ – في عدد متزايد من الوقائع – إلى جلادين وأحيانًا إلى منفذي إعدامات جماعية لأسر كاملة. الأرقام الرسمية وشبه الرسمية لا تترك مساحة للإنكار: نحن أمام انفجار عنف مكتوم داخل الجدران، تغذّيه ضغوط اقتصادية ساحقة، واختلالات نفسية غير مُعالَجة، وتآكل في روابط الحماية والدعم الاجتماعي، بينما تكتفي الدولة بخطاب أخلاقي مكرر وإجراءات أمنية بعد وقوع الكارثة، كأن الدم الذي سال داخل البيت شأن خاص لا تعنيه السياسات العامة.
أرقام مفزعة: تضاعف الجرائم الأسرية وتحول الخلاف إلى قرار بالقتل
بيانات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تكشف قفزة حادة في حجم الجريمة داخل الأسرة: 320 جريمة أسرية عام 2015 ارتفعت إلى 650 جريمة عام 2019، أي أن المعدلات تضاعفت في أربع سنوات فقط، مع تنوع واضح في أنماط الاعتداء يشمل القتل، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والسرقة داخل نطاق الأسرة نفسها. تقرير مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة» يذهب أبعد، برصده نحو 1250 جريمة عنف أسري في عام واحد فقط، بما يعني أن الجريمة الأسرية تضاعفت نحو أربع مرات خلال عقد.
هذه الأرقام ليست مجرد منحنى إحصائي؛ إنها مؤشر على تحوّل نوعي في كيفية حسم الصراع داخل البيت. ما كان ينتهي قبل سنوات بالطلاق أو القطيعة أو الهجر، صار في عدد متزايد من القضايا يُحسم بالقتل: زوج يذبح زوجته ويذهب بعدها لصلاة الفجر في الخصوص، أب يقتل ابنه خنقًا في الفيوم بدعوى «الدفاع عن العرض» قبل أن تُسقط محكمة الجنايات هذه الذريعة وتدينه، رجل يقتل زوجته ويواصل حياته عامًا كاملاً ثم يُلقي أبناءه الأربعة في مياه الملاحات في الإسكندرية، وزوجة أب في المنيا تُسمّم زوجها وأبناءه الستة دفعة واحدة. نحن أمام انتقال من «فورة غضب» إلى نمط إبادة أسرية مكتمل الأركان، يُنظر فيه إلى الأسرة بوصفها عبئًا يجب التخلص منه.
مصادر قضائية في مكتب النائب العام تتحدث صراحة عن «قفزة هائلة» في الجرائم الأسرية خلال السنوات العشر الأخيرة، ليس فقط في العدد، بل في مستوى التخطيط والتنكيل واستهداف أكثر من ضحية داخل الأسرة الواحدة، بما يعكس تغيرات عميقة في البنية النفسية والاجتماعية، ويطرح سؤالًا سياسيًا وأخلاقيًا في آن واحد: كيف وصل المجتمع إلى لحظة يصبح فيها قتل الأسرة خيارًا مطروحًا على طاولة بعض الأفراد؟
«وصاية قاتلة» وأمومة منكسرة: سلطة مشوّهة تتغذى على الفقر والمهانة
الصدمة الأكبر ليست في عدد الجرائم فقط، بل في طبيعة دوافعها. في قضايا متتابعة، تظهر «الوصاية القاتلة» كعنوان لعنف يحتمي بخطاب الشرف والسلطة الأبوية: أب في الشرقية يخنق ابنته ذات الـ17 عامًا لأنها تريد إكمال تعليمها وفسخ خطوبتها، وثلاثة من أفراد عائلة واحدة في الجيزة يقتلون فتاة لأنها تزوجت دون علم الأسرة رغم ثبوت شرعية الزواج. هذه الجرائم تعيد إنتاج نموذج «الولي الذي يملك الجسد والقرار» لكن في صورة قتل بارد لا مكان فيه لأي معنى للحماية أو الرحمة.
في حالات أخرى، يتحوّل الأبناء إلى أدوات انتقام متبادل بين الزوجين. جريمة منطقة فيصل في الجيزة تكشف ذلك بوحشية: أم تترك أبناءها الثلاثة بعد خلافات مع الزوج، فيموت أحدهم جوعًا وهزالًا ويُعثر على الآخرين في حالة انهيار جسدي، ثم تظهر محاولات للتخلص منهم عبر إلقائهم في ترعة قريبة. هنا لا تكون الأمومة قد تآكلت فقط، بل انكسرت وتحولت إلى سلاح ضد الأب، في سياق اختلال نفسي عميق يغذّيه الفقر، والعزلة، والإحساس بالعجز، دون أي شبكة دعم فعّالة يمكن أن تتدخل قبل أن تتحول الأزمة إلى جريمة.
جريمة الزوج الذي ذبح زوجته ثم ذهب للصلاة ليست استثناءً أيضًا؛ فهو يعترف بأن السخرية المستمرة من فقره وضيق حاله فجّرت غضبًا مكبوتًا تحوّل في لحظة إلى قتل. الفقر والضيق هنا ليسا مجرد خلفية اجتماعية، بل وقود مباشر للعنف. تقارير جنائية خلال النصف الأول من العام الماضي تؤكد أن الطعن والخنق يتصدران أدوات القتل داخل الأسرة، وأن المحافظات الكبرى – حيث الكثافة السكانية، والبطالة المقنّعة، وضغوط المعيشة – تسجل النسب الأعلى. المخدرات التخليقية، وعلى رأسها «الشبو»، حاضرة بقوة في جرائم قتل الأصول، وتزيد من احتمالات الانفجار العنيف لدى أشخاص بلا سوابق جنائية، فيتحول مواطن «عادي» إلى قاتل في لحظة.
مجتمع يُجرَّد من مناعته النفسية.. ودولة تتفرج من بعيد
الخبراء الذين يتابعون الظاهرة يربطون بوضوح بين هذا الانفجار العنيف وبين انهيار فكرة الصحة النفسية كجزء من الرعاية الأساسية. الدكتورة رشا محمد، أستاذة علم النفس بجامعة بني سويف، تؤكد أن تصاعد الجرائم الأسرية «لا يمكن فصله عن تراكم طويل من الضغوط النفسية غير المُعالَجة»، فالمجتمع يعاني إنكارًا واسعًا لفكرة المرض النفسي؛ يُفسَّر الاكتئاب الحاد والذهان بأنه «ضعف إيمان» أو «سوء تربية»، فتُترك الحالات من دون تشخيص أو علاج حتى تنفجر في صورة عنف غير متوقع داخل البيت.
من جهته، يحذر استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز من أن ما نراه اليوم «ليس ذروة الظاهرة بل بدايتها»، معتبرًا أن المجتمع يمر بحالة تآكل أخلاقي ونفسي متسارع نتيجة ضغوط معيشية خانقة، وانفتاح غير منضبط على أنماط سلوكية عنيفة، وانتشار مخدرات تؤدي إلى البارانويا والذهان. الأخطر – كما يقول – هو «الاعتياد على العنف»، إذ لم تعد الجريمة الأسرية تصدم أحدًا كما في السابق، بل تُستهلك كخبر عابر على مواقع التواصل، ما يُفقد المجتمع تدريجيًا حساسيته الأخلاقية ويطبع الغضب كحالة عامة بلا قنوات صحية للتفريغ.
في مواجهة كل ذلك، تكتفي الدولة غالبًا بخطاب وعظي عن «التفكك الأسري»، مع ترك الصحة النفسية على هامش الموازنة، وتهميش مراكز الإرشاد والدعم الاجتماعي، وغياب برامج جدية لاكتشاف الأسر الهشّة قبل الانفجار. المواجهة الأمنية ضرورية لمعاقبة الجناة، لكنها لا تمنع الجريمة التالية، ولا تعالج جذور الأزمة: اقتصاد خانق يطحن الأسر، وصورة رجولة مشوّهة تُشرعن القسوة، وثقافة خجل من طلب المساعدة النفسية، وإعلام يستثمر في دراما العنف بدلًا من أن يعرّي أسبابها.
الأخطر أن البيت، آخر ما تبقّى للمصري من مساحة افتراضية للأمان بعد انسداد المجال العام، يتحوّل هو نفسه إلى ساحة قتل. وعندما تصبح الجدران التي يفترض أن تحمي هي مصدر الخطر، فهذا يعني أن المجتمع يفقد آخر خطوط دفاعه الداخلية، وأن الحديث عن «الجريمة الأسرية» لم يعد مسألة قانونية فقط، بل إنذارًا مبكرًا بانهيار تماسك اجتماعي إذا استمر تجاهله ستدفع البلاد ثمنه لعقود مقبلة.