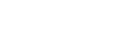لا خلاف على أن أحمد الطيب نجح في الحفاظ على قدر من هيبة منصب شيخ الأزهر، ورفض اختزاله في دور “الموظف الديني” التابع للسلطة التنفيذية. تمسكه بالتقاليد الأزهرية الأشعرية والصوفية، وحرصه على صورة الأزهر كمرجعية لأهل السنة، منحه رصيدًا رمزيًا لا تستطيع السلطة تجاوزه بسهولة.
لكن هذا الاستقلال ظل “منضبطًا بسقف” لم يُكسر: الأزهر لم يتحول في عهده إلى منصة معارضة حقيقية للانقلاب أو سياساته، بل إلى ضمير أخلاقي يرسل إشارات تحفّظ واعتراض محسوبة، دون أن يغامر بتحويلها إلى موقف صدامي مفتوح.
رابعة وتجديد الخطاب الديني.. اعتراض بلا قطيعة
في لحظة فض اعتصام رابعة، مثّل تبرؤ الطيب من سفك الدماء وابتعاده المؤقت عن المشهد العام موقفًا مهمًا مقارنة بصمت كثيرين. هذا الموقف ثبّت صورته كشيخ يرفض أن يُستَخدم لتبرير القتل، وعرّضه بالفعل لهجوم إعلامي من أذرع السلطة.
لكن، ورغم ثقل الحادثة، لم تتطور هذه “المسافة الأخلاقية” إلى مراجعة جذرية لعلاقة الأزهر بالانقلاب، ولا إلى دفاع صريح عن الضحايا أو عن حق المصريين في التمثيل السياسي. تحوّل الموقف إلى “نقطة في السيرة” أكثر منه مسارًا مستمرًا لمقاومة الظلم. الأمر نفسه تكرر في ملف “تجديد الخطاب الديني”: رفض الطيب تحويل الفكرة إلى أداة لإخضاع الدين لمزاج السلطة، لكنه لم يربط بوضوح بين الاستبداد السياسي وإنتاج التطرف، مكتفيًا بالدفاع عن ثوابت المنهج الأزهري في وجه التدخل الفوقي.
معركة تسييس الأزهر واستقلال منقوص
لا يمكن إنكار أن الشيخ الطيب تصدى لمحاولات تشريعية وإعلامية لجر الأزهر إلى خندق التبعية الكاملة، وتمسك بالنص الدستوري الذي يضمن استقلال المؤسسة، ونجح – حتى الآن – في منع تحويل المشيخة إلى إدارة من إدارات الدولة.
لكن هذه المعركة، التي كسب فيها الأزهر نقاطًا مهمة، لم تُترجم إلى انحياز واضح لضحايا نفس الدولة التي تحاول ترويضه. بقي الأزهر “مستقلًا” في البنية، لكنه حذر للغاية في المضمون السياسي؛ ينتقد الغلو والتكفير، لكنه لا يقترب من جوهر المظالم التي تصنع هذا الغضب في الشارع. وهنا يظهر الخلل: استقلال المؤسسة لم يُستخدم لتقديم خطاب ديني منحاز بوضوح للحرية والعدالة وحقوق الناس، بل لضبط التوازن بين رضا السلطة والحفاظ على ماء وجه الأزهر.
غزة وفلسطين.. شجاعة خارج الحدود وصمت داخلها
في ملف فلسطين وغزة، قدم أحمد الطيب واحدًا من أكثر المواقف وضوحًا في الساحة الرسمية المصرية؛ سمّى الأشياء بأسمائها: احتلال، عدوان، جرائم حرب، ورفض لغة “الحياد الكاذب” أو المساواة بين الضحية والجلاد. هذا الموقف منحه رصيدًا ضخمًا لدى الشعوب المسلمة، وأكد أن الأزهر ما زال قادرًا على النطق بالحق عندما يبتعد الملف عن الحسابات الداخلية الضيقة.
لكن هذه الشجاعة الخارجية لا تجد دائمًا نظيرًا لها في الداخل؛ فبينما يتحدث الأزهر بقوة عن كرامة أهل فلسطين، يبقى خطابه أكثر عمومية حين يتعلق الأمر بكرامة المصريين وحقوقهم المنتهكة تحت قبضة الأجهزة. هنا يظهر الحد الفاصل بين عالمٍ يُدرك الظلم جيدًا، لكنه يختار أن يعارضه في الملفات “المسموح بها” أكثر مما يفعل في ساحته المحلية.
مقام عالٍ.. وخيارات ناقصة
الشيخ أحمد الطيب، في الثمانين من عمره، هو بلا شك واحد من أهم علماء العصر ومراجع المسلمين، ورمز نادر لمؤسسة دينية لم تُبتلع بالكامل داخل ماكينة السلطة. لكنه أيضًا مثال على حدود “الاستقلال الهادئ” في زمن الانقلاب: استقلال يحمي الأزهر من الذوبان، لكنه لا يحمي المجتمع من عسف الدولة، ولا يحوّل مكانة المشيخة إلى قوة أخلاقية تدافع صراحة عن المظلومين في الداخل كما تفعل في قضايا الأمة الكبرى.
اللوم الأكبر يبقى على منظومة الحكم التي تريد من العلماء أن يكونوا زينة للشرعية لا ركيزة للعدل؛ غير أن التاريخ سيحاسب أيضًا رموز العلم على ما فعلوه بما أتيح لهم من وزن ومقام. وفي حالة أحمد الطيب، سيظل السؤال مفتوحًا: هل كان يمكن للأزهر أن يكون، في زمن الاستبداد، صوتًا أعلى في وجه الظلم، لا مجرد صوت منخفض الدرجة في سجل الاعتراض المحسوب؟