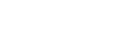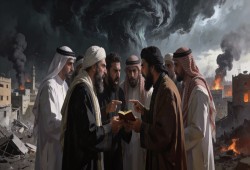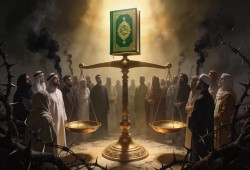يرى الدكتور عمر عبيد حسنة أن الشفاعة الحسنة التي عرفها المجتمع الإسلامي الأول لم تعد تمارس بنفس صورتها اليوم، إذ كانت في العصور السابقة وسيلة لتفريج كرب الناس عبر وساطة العلماء والوجهاء لدى الحكام، أما الآن فقد أصبح المجتمع أكثر تعقيدًا وتحضّرًا، مما استدعى ظهور قنوات جديدة كالبرلمانات والجمعيات والأحزاب التي تمثل الناس وتتحدث باسمهم. غير أن هذه الهياكل، رغم وجودها، لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب غياب الوعي الشرعي والاجتماعي الذي ينظمها ويضبط مسارها.
ويشير إلى أن الشفاعة في أصلها تعبير عن مبدأ التكافل والتراحم الذي غرسه الإسلام في نفوس المؤمنين، مستدلًا بسلوك الأنبياء الذين تبنوا هموم أقوامهم ودافعوا عن المستضعفين، مثل شعيب ويوسف وموسى عليهم السلام. ويخلص إلى أن الدين ليس عبادات فردية فقط، بل منظومة متكاملة تتجسد في عمل صالح يخدم المجتمع، وأن الإيمان الحقيقي لا يثبت بمجرد القول، بل بالعمل الذي يترجم الرحمة والتكافل والتعاون إلى واقع ملموس. فالمطلوب اليوم هو إحياء مبدأ الشفاعة الحسنة عبر اجتهادات شرعية وتنظيمية وتربوية تعيد لهذا الأصل الإسلامي دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الناس.
من الشفاعة التقليدية إلى الشفاعة المؤسسية
إن واقعنا اليوم، أقل ما يمكن أن يقال فيه: إنه يختلف كثيرًا عن الواقع النبوي، وعن الواقع في العصور التي تلت، إلى عهد قريب، حيث كانت الشفاعة تتم عبر العلماء، والوجهاء، والأعيان، عن طريق المثول أمام الخليفة، أو السلطان، أو الوالي، بقصد قضاء حاجات المحتاجين، وسد خلتهم، أو إطلاق سراح بعض المعتقلين. وسوف تأتي معنا أمثلة عن هذا، إن شاء الله.
غير أن هذه القناة وحدها أصبحت غير كافية، فهي – بالإضافة إلى كونها لا تضبط حركة استجابة المسؤولين لمطالب الذين يشفعون – تتركها رهينة بأمزجتهم وإراداتهم الخاصة، مما يجعلها تتسم بالاضطراب، وتكتسي – إن حصلت – ثوب الإنعام والتفضل، مما ليس دائمًا صحيحًا.
وإلى جانب هذا، فإن الشفاعة بهذا النمط وحده، لا تلائم مقتضيات المجتمع المائل إلى التمدن – حال مجتمعاتنا – التي تفرض استعمال قنوات وآليات أخرى لامتثال الأمر بالشفاعة الحسنة الذي جاء في الكتاب والسنة.
التحولات الاجتماعية والسياسية في ممارسة الشفاعة
في العصر الحديث أصبح الناس يعيشون في مدن تتكاثف فيها السكنى، ولا يجمعهم إلا أسباب العيش المشترك، وعلى مضض كبير. وقد تمت محاولات جادة لجمعهم في إطارات تنظمهم، فأنشئت لهذا السبب القوانين التي تنظم إحداث الجمعيات والأحزاب والمؤسسات التي تسهم في تأطير المواطنين.
كما تم تقنين طرق إجراء الانتخابات لاختيار مندوبين عن الشعب يمثلونه ويتحدثون باسمه، أي “يشفعون له شفاعة حسنة” في المحافل المخصصة لذلك. كما ضُبطت – ولو بقدر من الاضطراب – آليات للتعريف بمن يُفترض فيهم أن يكونوا أكفياء لهذا الشأن.
قصور الوعي وضرورة الاجتهاد الشرعي والتنظيمي
غير أن كل هذا، وفي غياب الوعي الممكن للتعاطي معه إيجابيًا وتنظيمه بما يلائم أرضيتنا القيمية وفضاءنا الحضاري وخلفيتنا التاريخية وبنيتنا الاجتماعية بمختلف أبعادها، يبقى غير قادر على تأطير واقعنا بشكل كافٍ وفعّال.
وهذا يستلزم اجتهادات متجددة في هذا الاتجاه: شرعيًا، وتنظيميًا، وتربويًا، وتعبويًا، للوصول إلى المقصد من إحداث كل هذه القنوات والآليات، وهو تفريغ هموم الناس بعد تبنيها بشكل ممنهج مسترشد بالشرع الحنيف، من أجل الفوز بالنصيب من الشفاعة الحسنة الذي وعد به الله ورسوله ﷺ.
الأنبياء نموذجًا في تبني هموم الناس
لقد بين القرآن الكريم أن الأنبياء كان من مهامهم الأساسية – بعد الدعوة إلى الله – تبني هموم أقوامهم وآلامهم وآمالهم.
فهذا نبي الله شعيب يتبنى هموم المستضعفين من قومه، فيخاطب المستكبرين بقوله تعالى: (أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [الشعراء: 177–183].
وهذا نبي الله يوسف يتبنى مشاكل وهموم الناس في السنين العجاف، ويتطوع لتحمل عبء توزيع المواد الغذائية بعدل، فيقول تعالى حكاية عنه: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) [يوسف: 55].
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: “وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه، ولما فيه من المصالح للناس، وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض التي يجمع فيها الغلات، لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد.”
وهذان نبيّا الله موسى وهارون يطالبان فرعون، أول ما خاطباه، بإطلاق سراح بني إسرائيل وعدم تعذيبهم والكف عن استضعافهم واستغلالهم، فقال تعالى حكاية عنهما: (إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) [طه: 47].
الإسلام منهج تكاملي يقوم على التكافل والتراحم
نستخلص من هذه الآيات الكريمات أن هذا الدين العظيم قد غرس في المؤمنين التكافل والتراحم والتعاون، وجسّد ذلك في سلوك الأنبياء الذين خلقوا ليُقتدى بهم.
وجعل عدم الانخراط في هذه الأوامر الإلهية تكذيبًا بالدين، لأن هذا الدين ليس أجزاء متفرقة يؤدي منها الإنسان ما يشاء ويدع ما يشاء، بل هو منهج متكامل تتعاون فيه عباداته وشعائره وتكاليفه الفردية والاجتماعية، حيث تنتهي جميعها إلى غاية واحدة تعود على البشر بالنفع.
غاية تتطهر معها القلوب، وتصلح الحياة، ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح والنماء، وتتمثل فيها رحمة الله السابغة بالعباد.
الإيمان والعمل الصالح أساس الشفاعة الحقيقية
قد يقول الإنسان بلسانه إنه مسلم ومصدق بهذا الدين، وقد يصلي ويؤدي شعائر أخرى، ولكن حقيقة الإيمان والتصديق تظل بعيدة عنه ما لم تظهر علاماتها في سلوكه.
فالإيمان الحقيقي حين يستقر في القلب يتحرك فورًا ليحقق ذاته في عمل صالح، والتصديق بالدين ليس كلمة تقال باللسان، بل هو تحول في القلب يدفع صاحبه إلى الخير والبر بإخوانه في الإنسانية المحتاجين إلى الرعاية والحماية.
والله – سبحانه وتعالى – لا يريد من الناس كلمات، بل أعمالًا تصدقها، وإلا فهي هباء لا وزن لها ولا اعتبار.