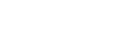محمد الشبراوي حسن
كاتب صحافي
تمر ذكرى مولد النبي محمد ﷺ هذا العام على وقع مجازر متواصلة في غزة، في لحظة إنسانية مأزومة لا تشبه ما سبقها، من حيث حجم الألم، ولا من حيث عمق الصمت.
لا تبدو غزة مجرد مدينة جريحة، بل مرآة تعيد إلينا جوهر الرسالة النبوية في مقاومة الظلم، والانتصار للضعفاء، والثبات على الحق في وجه الطغيان.
وغزة اليوم بصمودها ليست بعيدة عن تلك الرسالة، بل هي تجسيدها الأوضح في زماننا المعاصر.
تتزامن هذه الذكرى مع مرور أكثر من 22 شهرًا على العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي لا يزال يحصد الأرواح، ويهدم البيوت، ويقلب مفاهيم القانون والعدالة، وسط تواطؤ دولي، وخذلان عربي وإسلامي، يعرّي كثيرًا من الشعارات التي تُرفع في مناسبات مثل المولد النبوي.
لكن في هذا التوقيت تحديدًا، تصبح العودة إلى السيرة النبوية ضرورة، ليس للاحتفاء العاطفي بها، بل لاستخلاص المعنى، وتفكيك الرسائل التي تحملها لنا اليوم؛ أفرادًا وشعوبًا وأمة، فمولد النبي لم يكن ولادة رجل، بل انبثاق مشروع تحرري أخلاقي، في عالم كان غارقًا في الظلم والجهل والتفرقة.
غزة الآن.. المعنى الكثيف للاستضعاف
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تعيش غزة تحت قصف متواصل، لم يسلم منه حجر ولا بشر، قصف لم تنجو منه المستشفيات ولا المدارس ولا المساجد وسائر دور العبادة، ولا حتى سيارات الإسعاف ومراكز الإيواء، أكثر من 62 ألف شهيد حتى لحظة كتابة هذا المقال، أغلبهم من الأطفال والنساء.
المشهد لا يحتمل التوصيف المعتاد، هناك محاولة خنق جماعية لنحو مليونين ونصف المليون إنسان، يُمنَعون من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، ويُتركون ليواجهوا مصيرًا فُرض عليهم لأنهم فقط فلسطينيون.
هذا الوضع لا يمكن عزله عن المفهوم القرآني لـ”الاستضعاف”.
يقول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (النساء: 97-98).
القرآن يفرّق بين من يصمت خوفًا، ومن يُقاوم رغم الاستضعاف. وغزة -بكل ما فيها من أنقاض وصراخ – تقول للعالم “لسنا ضحايا، نحن أصحاب حق يقاتل كي لا يُنسى”.
من سيرة النبي إلى ذاكرة غزة.. خيط المقاومة
عاش النبي ﷺ مراحل متدرجة من الضعف: الحصار الاقتصادي في شِعب أبي طالب، العزلة الاجتماعية، فقد السند، والاضطهاد، والشتات. لكن كل ذلك لم يُثنه عن مواصلة المشروع. لم يكن نبيًّا يطلب العزلة أو المهادنة، بل كان يرى المواجهة ضرورة إذا مُسَّت الكرامة أو انحرف الميزان.
في “عام الحزن”، حين فقد زوجته خديجة وعمه أبا طالب، ورفضته الطائف بالحجارة، عاد ﷺ وهو ينزف، جسديًّا ومعنويًّا، لكنه قال “إن لم يكن بك غضبٌ عليَّ، فلا أبالي”.
رسالة تحتملها غزة اليوم بكل وضوح: الثبات على الطريق، لا رغم الألم بل بسببه.
اليوم، يقف جزء من النظام الرسمي العربي في موقع العجز، أو الحياد، أو الشراكة الضمنية مع الاحتلال، تحت عناوين “السلام” و”الاستقرار” و”مصالح الدولة”. لكن الحقيقة واضحة: كل دقيقة صمت عن قتل الأطفال في غزة، تعني مسامحة للقاتل.
هل تكفي الإدانة؟ السيرة تقول: لا.
النبي ﷺ لم يُدِن فقط ما وقع على المظلومين، بل سعى لتغيير واقعهم. لم يكتف بالقول، بل بنى نواة مجتمع جديد في المدينة، على أساس النصرة المتبادلة والعدل الشامل.
حين آخى بين المهاجرين والأنصار، لم يكن ذلك عملًا رمزيًّا، بل مشروعًا سياسيًّا واقتصاديًّا، يواجه واقع التشريد بالتمكين، والجوع بالإيثار. يقول الله تعالى في وصف الأنصار {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (الحشر: 9).
فهل نملك نحن اليوم مشروعًا حقيقيًّا لنصرة غزة؟ أم أن الإدانة أصبحت بديلًا عن الفعل؟
واجبنا اليوم استحضار المعنى لا المناسبة، فالاحتفاء بمولد النبي ﷺ لا ينبغي أن يكون طقسًا دينيًّا فقط، بل موقفًا أخلاقيًّا. فالنبي الذي وُلد في بيئة عنصرية طبقية ظالمة، لم يرضَ بالتعايش معها، بل قلب موازينها، وأعلن أن “الناس سواسية”، وأن “أحبَّ الناسِ إلى الله أنفعُهم للناس”.
وأمام ما يحدث في غزة، يمكن تلخيص واجبنا في:
- الوعي، ورفض الرواية الرسمية التي تساوي بين الضحية والجلاد، والتمسك بالسردية الفلسطينية كما يرويها أهلها، لا كما تُفلترها غرف الأخبار الممولة سياسيًّا.
- الضغط على الحكومات والأنظمة، داخليًّا وخارجيًّا، لوقف أشكال التطبيع، ولتقديم دعم حقيقي للمقاومة السياسية والحقوقية والإغاثية.
- الدعم المادي والمعنوي والإعلامي، وهذا ليس اختيارًا تطوعيًّا، بل هو التزام ديني وأخلاقي وإنساني.
- البقاء في المشهد، فجزء من استراتيجية الاحتلال هو إغراق الناس في تفاصيلهم اليومية، ليملّوا من أخبار غزة، لكن استمرارية الذاكرة مقاومة قائمة بذاتها.
هل يتذكرنا النبي لو رأى غزة؟
ليس سؤالًا عاطفيًّا، بل سؤال مسؤولية، فالنبي ﷺ قال “مَن لم يهتمَّ بأمرِ المسلمين فليسَ منهم”.
هل اهتمامنا بغزة موسمٌ عابر؟ أم أنه وعي ممتد، ومسؤولية يومية، وولاء أخلاقي يتجاوز السياسة والحدود؟
في زمن تتراكم فيه التناقضات، وتُفرغ القيم من محتواها، تعيد غزة ترتيب الأسئلة: من نحن؟ وما الذي تبقى من الرسالة؟ وهل ما زلنا نعي ما تعنيه كلمة “أمة”؟
في ذكرى مولده ﷺ، يبدو السؤال الأكبر: كيف نستحق أن نُنسب إليه؟
الرسول الذي واجه الحصار والخذلان والطعن، ومضى في مشروعه حتى النهاية، لا يمكن أن يرضى بأن نكون شاهدين على مجزرة، ثم نعود إلى حياتنا وكأن شيئًا لم يكن.
غزة، بكل ما فيها، ليست قضية وطن فحسب، بل قضية معنى يجسد الوجود والكرامة. وإذا كانت المدينة المحاصرة تُذكّرنا كل يوم بأنها حية، فهل نحن كذلك؟ وهل لا يزال فينا من يحيا بالرسالة، لا فقط يحتفل بها؟
في الختام
إن رسالة الإسلام، وهدي القرآن، وسيرة النبي محمد ﷺ، ليست مجرد تراث محفوظ أو وقائع من زمن انقضى، بل هي مَعين لا ينضب لمن أراد البصيرة في زمن المِحن والتشويش، وهي مرآة يرى فيها المؤمن مواقفه ومراجعاته ومكانه من الأحداث. وليس لكاتب هذه السطور، ولا لمن يكتب في شؤون الأمة وهمومها، ما هو أثمن من أن يعود إلى ذلك المَعين، وأن يستلهم من سيرة النبي ﷺ وهديه ما ينير البصيرة، ويهدي الكلمة، ويصلح الموقف. فالأمة اليوم في مفترق طرق، والمحنة التي تعيشها غزة ليست سوى وجه واحد لأزمة أكبر تحتاج أن يُسترجع فيها النور الأول، والنبض الأول، والرسالة المحمدية التي كانت من أول يوم خطابًا للإنسان المستضعف والضمير الحي.