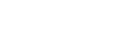إياد الجعفري
كاتب وباحث سوري
في نهاية شهرٍ حافلٍ بالتحوّلات النوعية، الميدانية والسياسية، في شمالي سورية وشرقيّها، يصبح من المُغري للمراقب محاولة تفكيك سرّ أحد أهم العوامل التي وفّرت الإمكانية لتحقيق هذه التحوّلات؛ وهو الانكفاء الأميركي عن تثبيت خطوط الاشتباك وخرائط السيطرة بين الحكومة السورية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ذاك التثبيت كان الغطاء لـ"قسد"، ووفّر لها هامشًا واسعًا من المناورة طوال العام الفائت (2025). وهو الهامش الذي تضاءل بصورة دراماتيكية خلال الشهر الماضي (يناير).
كان لهذا "الانكفاء" الأميركي عن تحصين "قسد" وقع الصدمة على قيادات في التنظيم، وعلى نُخب كردية، فوصفه بعضهم بـ"الخيانة"، فيما وصفه محلّلون أكثر حيادية بـ"التخلّي"، لتتعدّد النظريات والتفسيرات حول سببه وسرّ توقيت حدوثه.
شكلان للرعاية الأميركية
في ليل 6 أكتوبر 2025، وعقب ساعاتٍ من بدء اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي "قسد" في أطراف حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تمكّنت وساطة أميركية سريعة من دفع الطرفَين إلى وقف إطلاق النار. وشهد اليوم التالي اجتماعات في دمشق حضرها قادة "قسد" ومسؤولو الحكومة. وجرت المفاوضات بقيادة قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، الجنرال براد كوبر، وبمشاركة المبعوث الأميركي توم برّاك. وكانت لافتة طبيعة الرعاية الأميركية الحثيثة لـ"قسد" في تلك الفترة.
مثالًا، كان التدخّل الأميركي ميدانيًا وسياسيًا مباشرًا وسريعًا أيضًا، بغية التهدئة لمنع انفجار العلاقة بين "قسد" والمكوّن العشائري العربي، إثر أحداث قرية كرهوك بريف القامشلي نهاية أكتوبر 2025. وقد اندلعت اشتباكات وتوتّرات جديدة بين مقاتلي الحكومة و"قسد" في مدينة حلب في الأسبوع الأخير من العام 2025، وحظيت كذلك بتدخّلٍ أميركي سريع؛ إذ أجرى فريق الخارجية الأميركية المعني بسورية، والموجود في الأردن، اتصالات مباشرة مع الجانبَين بهدف وقف الاشتباكات. وكان التدخّل الأميركي في كل الأحداث السابقة سريعًا من حيث التوقيت (ساعات بعد بدء الاشتباكات)، وهدفه الإبقاء على خطوط الاشتباك وخرائط السيطرة مستقرّة كما هي، من دون تغيير.
إلّا أن سمات التدخّل الأميركي تغيّرت مع التوتر الميداني التالي، الذي بدأ في 5 الشهر الماضي (يناير). فقد تأخّر التدخّل الأميركي المباشر خمسة أيام، وسبقه إعلان لافت للبيت الأبيض جاء فيه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم قيام سورية مستقرّة وموحّدة وذات سيادة، تعيش بسلام داخل أراضيها ومع دول الجوار، معتبرًا أن ذلك يشكّل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية الإدارة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، وهو تصريح يميل إلى كفّة طرف (الحكومة السورية) على حساب الطرف الآخر (قسد) بوضوح.
وفي 10 يناير الماضي، جاء التدخّل الأميركي المباشر بزيارة توم برّاك دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع. وجاءت الزيارة فيما كان الجيش السوري يجهّز لاقتحام حي الشيخ مقصود في حلب، بعد أن أتمّ السيطرة على حيَّي الأشرفية وبني زيد. ولافتٌ أن زيارة برّاك دمشق جاءت بعد بيان مشترك أصدره برفقة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، جاء فيه تأكيد "دعم الجهود المُستهدِفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لمسلّحي "قسد" من حلب، وضمان أمن وسلامة جميع المدنيين"، أي أن هدف التدخّل الأميركي، وفق ما يوحي به هذا البيان، تنظيم خروج مقاتلي "قسد" من حلب، وليس توفير مظلّة لتثبيت خطوط الاشتباك التي كانت ما تزال قائمةً لحظة صدور البيان، كما كان يحدث في التدخّلات الأميركية السابقة.
لاحقًا، تسارعت التطوّرات الميدانية بوتيرة أسرع من التحرّكات السياسية، وتهاوت سيطرة "قسد" في نحو أسبوع لتخسر حوالى 80% من المساحات التي كانت تسيطر عليها سابقًا. وخلال هذه التطوّرات الميدانية، لم تبذل القوات الأميركية الموجودة في المنطقة أيّ جهد أو إجراء لدعم "قسد"، أو للجم تقدّم القوات الحكومية ومقاتلي العشائر الموالين لها. واكتفت واشنطن بإدارة مفاوضات هدفها احتواء تداعيات انهيار "قسد" الميداني، وتنظيم مخرج سياسي لها يحفظ حدًّا أدنى من مبرّرات وجودها. فما الذي حدث حتى تغيّرت سمات التدخّل الأميركي لصالح "قسد" خلال ثلاثة أشهر؟
ما بين أكتوبر 2025 ومطلع العام الجاري، مرّت العلاقات بين الحكومة السورية والإدارة الأميركية بثلاثة تطوّرات لافتة. تمثّل الأول في استقبال الشرع في البيت الأبيض ولقائه ترامب، بوصفه أول رئيس سوري يزور العاصمة الأميركية رسميًا، وذلك بعد أيام فقط من شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، من لوائح الإرهاب الخاصّة بالأمم المتحدة في تصويت لمجلس الأمن. تلا ذلك التطوّر الثاني، الإعلان رسميًا عن انضمام سورية إلى التحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بقيادة الولايات المتحدة. وتمثل التطوّر الثالث في توقيع ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تضمّن بند إلغاء قانون قيصر للعقوبات، وذلك بعد مصادقة الكونغرس بمجلسَيه على القانون، وهو ما اعتبره محلّلون أميركيون "إعلان فصل جديد في السياسة الأميركية تجاه سورية".
لكن محلّلين مقرّبين من "قسد" تجاهلوا التطوّرات السابقة، وركّزوا في تطوّرٍ رابعٍ مختلف، اعتبروه الأساس في التغيّر النوعي في الموقف الأميركي من التنظيم الكردي. ففي 4 يناير الماضي، وبينما كانت المفاوضات بين وفد "قسد" ومسؤولي الحكومة السورية في دمشق تتقدّم باتجاه الاتفاق على آلية دمج مقاتلي التنظيم وكوادره في مؤسّسات الدولة، ووفق رواية شخصيات محسوبة على "قسد"، جرى فضّ الاجتماع بصورة مفاجئة، ورفض مسؤولو الحكومة إصدار بيان بالتطوّرات الإيجابية التي شهدتها المفاوضات، وطلبوا تأجيل ذلك أيامًا عدّة. وفي اليوم التالي، كان ممثّلون عن الحكومة السورية يعقدون جولة مفاوضات جديدة مع وفد إسرائيلي، برعاية أميركية، في باريس.
نظرية اتفاق باريس الأمني
قيل وكُتب الكثير عن "اتفاق باريس الأمني" بين الحكومة السورية وإسرائيل. وقد صرّح قياديون في "قسد" أن العملية العسكرية التي شنّها الجيش السوري ضدّ تنظيمهم نالت الضوء الأخضر بموجب هذا "الاتفاق". لكن هل حدث "اتفاق" فعلًا؟
ظهرت أولى إرهاصات لقاء باريس التفاوضي في لقاء ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 30 ديسمبر 2025. وقد تعرّض الأخير لضغوط من ترامب لاستئناف التفاوض مع الحكومة السورية. وقد رفع الإسرائيليون سقف التفاوض، وفق تسريبات صحافية، بمقترح إنشاء مناطق أمنية عازلة جنوب غربي دمشق وفرض حظر جوي على الطائرات السورية قرب الحدود، مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغّلت فيها فور سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، على أن تحتفظ إسرائيل بمواقع استراتيجية في جبل الشيخ. ولاحقًا رُوّج بكثافة لنظرية أن الشرع قبل بالمطالب الإسرائيلية مقابل ضوء أخضر لـ"الاستفراد" بـ"قسد". واستند هذا الترويج إلى تسريباتٍ في الصحافة الأميركية أو العبرية.
وفي وقت لاحق، مرّر موقع أكسيوس الأميركي ومصادر صحافية عبرية ما يفيد بأن العقدة الرئيسة في المفاوضات كانت في تمسّك إسرائيل بالبقاء في قمّة جبل الشيخ ضمن أيّ ترتيباتٍ أمنيةٍ مقبلة، وهو ما يناقض نظرية "المنطقة العازلة" التي تشمل كامل الجنوب السوري، ما يؤشّر إلى أن التسريبات كانت تتناول مقترح الطرف الإسرائيلي الذي بدأت منه المفاوضات، لا ما جرى الوصول إليه في نهاية هذه الجولة التفاوضية.
ورسميًا، أصدرت الولايات المتحدة وسورية وإسرائيل بيانًا مشتركًا عقب اجتماع باريس أعلنوا فيه إنشاء خلية اتصال متخصّصة تكون منصّةً دائمةً للتنسيق في المجال الاستخباراتي وبغية خفض التصعيد العسكري والتواصل الدبلوماسي واستكشاف الفرص التجارية، بإشراف أميركي مباشر. وأوضح البيان أن هذه الخلية ستستخدم لمعالجة الخلافات على نحوٍ فوري ومنع سوء الفهم. في حين صدر إعلان أكثر تحفظًا من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكّد أنه اتُّفق على مواصلة الحوار، مشيرًا إلى أولويات إسرائيل الأمنية بمنع التهديدات على حدودها، إلى جانب الحفاظ على أمن الأقلية الدرزية في سورية. وهكذا نقرأ بين سطور الإعلانات الرسمية أنه لا "اتفاق" أمنيًا نهائيًا عُقد بعد، وأنّ "الاختراق" الذي تحدّث عنه توم برّاك في محادثات باريس كان تأسيس آلية لبناء الثقة بين الطرفَين لا أكثر، وذلك بغرض البناء عليها مستقبلًا في الجولات المقبلة من المفاوضات.
نظرية الضوء الأخضر الإسرائيلي
مرّرت في 21 يناير الماضي وكالة رويترز روايةً استندت إلى مصادر سورية "مطّلعة"، مفادها بأن المسؤولين السوريين في مفاوضات باريس اتهموا إسرائيل بدعم "قسد" في تأخير الاندماج ضمن الدولة السورية. واقترح المسؤولون السوريون، وفق الرواية، عملية محدودة لاستعادة بعض المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، ولم يتلقوا أيّ اعتراضات. في الوقت ذاته الذي تلقت فيه الحكومة السورية رسالةً منفصلة من تركيا تفيد بأن واشنطن ستوافق على عملية ضدّ "قسد" إذا جرى ضمان حماية المدنيين الكرد.
نظرية "الضوء الأخضر" الإسرائيلي والأميركي راجت بشدّة، خصوصًا في أوساط النخب الكردية والقيادات المحسوبة على "قسد". السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، وهو الذي قاد الوفد الإسرائيلي في مفاوضات باريس، ردّ على ما ورد في تقرير "رويترز" بالقول: "دعوني أكون واضحًا جدًّا: بما أنّني كنت حاضرًا طوال الاجتماع الثلاثي في باريس، لم تقبل إسرائيل أبدًا هجومًا من الجيش السوري على السوريين الكرد. أي ادّعاء بأننا فعلنا ذلك هو كذب". من الصعب الجزم إن كان السفير الإسرائيلي هو الذي "يكذّب"، أو أن المسؤولين السوريين الذين مرّروا هذه الرواية لـ"رويترز" أرادوا تعزيز حالة فقدان الثقة التي يشعر بها القادة الكرد تجاه أميركا وإسرائيل بصورة تخدم دمشق تفاوضيًا معهم. لكن ما يمكن الجزم به هو أن قدرة إسرائيل على الدعم المباشر لـ"قسد" لطالما كانت محدودة؛ إذ إنه، ولأسباب لوجستية ناهيك عن المخاطر الإقليمية على صعيد العلاقة مع تركيا، والأضرار التي يمكن أن تتسبّب بها على صعيد علاقتها المباشرة بالإدارة الأميركية، يصعب على إسرائيل أن تتدخّل مباشرة في شمال وشمال شرق سورية. ويبقى الجنوب السوري هو المجال المتاح لها لوجستيًا، وبذريعة حماية أمنها و"الأقلية الدرزية" التي تملك صلات مع "دروز إسرائيل".
لكن هل يعني ما سبق أنه لم يكن هناك "ضوء أخضر" أميركي لعملية الحكومة السورية ضدّ "قسد"؟
هل "خانت" أميركا "قسد"؟
إحدى أبرز الأصوات الخبيرة بالسياسة الأميركية التي رفضت توصيف "الخيانة" ونسبتها إلى "قسد" هو جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص بسورية في ولاية ترامب السابقة (بين 2018 و2020). وهو الذي خبر كواليس السياسة الأميركية حيال "قسد" عن قرب، قال في تصريحات له إنّ المسؤولين الأميركيين لطالما أكّدوا لقادة "قسد" أن علاقتهم مؤقّتة وتكتيكية، وتستند إلى هزيمة "داعش"، وأن واشنطن لم تقدّم للقادة الكرد أيُّ ضمانات سياسية أو عسكرية دائمة. وهي سياسة أكّدها توم برّاك بتصريحه الشهير في 20 يناير الماضي بأن انضمام سورية إلى التحالف الدولي ضدّ "داعش" غيّر جذريًا مبرّرات الشراكة الأميركية مع "قسد"، مشيرًا إلى أن الهدف الذي أُنشئت من أجله هذه الشراكة "انتهى إلى حدّ كبير". لكن هل كان ذلك مفاجأة لقادة "قسد" حقًّا؟
في مارس 2019، أعلن ترامب القضاء على "دولة الخلافة" الخاصّة بـ"داعش" بعد السيطرة على آخر معاقلهم في الباغوز بسورية. وفي أكتوبر 2019، أعلن ترامب مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في غارة أميركية بإدلب. ومن ثم أعلن أمرًا بسحب القوات الأميركية من قواعد عسكرية بصورة فُهمت على أنها ضوء أخضر لعملية عسكرية تركية كان جارٍ التحضير لها. ورغم أن ترامب تراجع جزئيًا عن قرار الانسحاب، إلّا أن قادة "قسد" كانوا قد تلقّوا الرسالة جيّدًا: أن "الحماية" الأميركية لهم غير مستدامة. وقد أعلن قائدهم مظلوم عبدي حينها أنهم ينظرون في الخيارات كلّها، بما في ذلك السعي إلى ترتيبات مع روسيا ونظام الأسد. وهو الاتجاه الذي سلكته "قسد" لاحقًا بالفعل؛ إذ نسجت علاقات تواصل قوية مع روسيا وفتحت قنوات تفاوض مع دمشق في عهد النظام البائد.
درس كردستان العراق
قبل تجربة "قسد" غير مكتملة المعالم مع إدارة ترامب عام 2019، عاش كرد العراق تجربةً أخرى أكثر اكتمالًا. ففي حين أصرّت قيادتهم في كردستان العراق على تنفيذ استفتاء على الاستقلال في سبتمبر 2017، أعلنت واشنطن معارضتها الشديدة لهذا الإجراء. ورغم الشراكة التي تمتدّ عقودًا مع قيادات الإقليم، تركت واشنطن قوات البشمركة "الكردية" وحيدةً في مواجهة هجوم القوات الحكومية العراقية المدعومة من "الحشد الشعبي" للسيطرة على مدينة كركوك المتنازع عليها، ردًّا على استفتاء "الانفصال". وقد فسّر المحلّلون الموقف الأميركي يومها بأنه مراعاة لحساسية تركيا من إعلان "الانفصال الكردي"، وخشية أن يؤدّي ذلك إلى تقارب تركي – إيراني – روسي أكبر يقلّص من النفوذ الأميركي في المنطقة، ويجعل واشنطن تخسر تأثيرها على النُّخبة الحاكمة في بغداد.
من خلال العرض السابق يتضح لنا أن قادة "قسد" كانوا قد تلقوا أكثر من إشارة تؤكّد أن الدعم الأميركي لهم ليس مطلقًا وليس مستدامًا؛ تصريحًا (على ذمة جيمس جيفري) وفعلًا، من خلال سياسات ترامب حيال حلفاء أميركا الكرد في المنطقة في ولايته السابقة. الأمر الذي يدفعنا إلى تقديم نظرية مختلفة عن النظريات التي راجت لتفسير ما حدث من جانب واشنطن حيال "قسد" خلال شهر يناير الماضي.
فواشنطن كانت حريصة على تعزيز قدرة "قسد" التفاوضية مع الحكومة السورية بدمشق منذ توقيع اتفاق مارس (2025)؛ إذ أبقت الغطاء العسكري والسياسي لها قائمًا. لكن قادة "قسد" لم يفهموا طبيعة الغاية التكتيكية المؤقتة لهذا "الغطاء" بوصفه دعمًا لهم لتحسين شروطهم التفاوضية مع دمشق كي يندمجوا في مؤسّسات الدولة بشروط أفضل. فماطلوا حتى تجاوزوا الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق. وهي مماطلة من الواضح أنها أزعجت الأميركيين أنفسهم. فكان "الضوء الأخضر" الأميركي لحكومة الشرع للقيام بعمل عسكري محدود ومنضبط بغية دفع قادة "قسد" للتفاوض بجدية أكبر. لكن ما حدث أن موازين القوى الحقيقية والمتفاوتة بشدّة انكشفت مع رفع "الغطاء" الأميركي، فانهارت "قسد" في وقت قياسي بصورة صدمت حتى الأميركيين، الذين انشغلوا بالتفاوض على إيجاد مخرج "مُشرّف" لـ"قسد"، ونقل معتقلي "داعش" الخطرين من سورية إلى العراق.
لماذا لم تدعم أميركا "قسد" حتى النهاية؟
إحدى الأجوبة متوافرة في التجارب السابقة التي أشرنا إليها: العلاقة مع تركيا، التي تهم أميركا عمومًا وإدارة ترامب خصوصًا، إلى جانب العلاقة مع قوى إقليمية مهمة في نظر الإدارة الأميركية مثل دول الخليج الداعمة لحكومة الشرع. كذلك الرهان على الدول المركزية المستقرّة، كما في الرهان على بغداد أكثر من "كردستان العراق"، ودمشق أكثر من "قسد".
ومع رحيل نظام الأسد وانتظام الحكومة السورية الجديدة في تحالف متقدّم مع واشنطن، لم يبقَ من قيمة للرهان على "قسد" بصورة تجعلهم يخسرون النفوذ على الحكومة في دمشق. وأبعد من ذلك، فرهان إدارة ترامب على إعادة إعمار سورية بتمويل إقليمي ودولي تستفيد منه الشركات الأميركية يتطلّب جملة شروط، أبرزها استقرار البلاد ووحدتها، ووجود حكومة مركزية يمكن التفاهم معها.
وأبعد من ذلك أيضًا، فالحرب على "الإرهاب السنّي"، وفق المفهوم الأميركي، عبر التعاون مع حكومة ذات خبرة عملية في تفكيك كثير من الحركات الجهادية والفصائل المتشدّدة، يبدو رهانًا معتمدًا في واشنطن، خاصّةً أن عيّنات من هذا التعاون قد اختُبرت مخابراتيًا في مرحلة "إدلب". وذلك رغم المخاوف الأمنية وعدم ثقة دوائر استخباراتية وعسكرية أميركية ببعض مراكز القوى والتيارات داخل تركيبة السلطة الراهنة في دمشق.
إلّا أن الرهان الأمني يتكامل في قيمته مع رهانات أميركية أخرى اقتصادية واستراتيجية وسياسية، تجعل من العلاقة مع دمشق أكثر قيمةً وأقلّ كلفةً من علاقة مع تنظيم يحمل أيديولوجية قومية ويسارية متطرّفة، مرفوضة محليًا وإقليميًا على نطاق واسع، كان يسيطر على مساحات شاسعة من الجغرافيا والديموغرافيا غير الصديقة له.