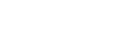تمثل مقدمة د. عمر عبيد حسنة مدخلًا لكتاب الدكتور زغلول النجار «قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر»، حيث تنطلق المقدمة من ربط مباشر بين معنى الاستخلاف وعمارة الأرض، وبين قيمة العلم والعمل والإتقان، لتقدّم قراءة نقدية لجذور الضعف الحضاري الراهن. تُبيّن أن عصور الازدهار ارتبطت بمدى استجابة المسلمين للخطاب القرآني في طلب العلم وحسن توظيفه، بينما اقترنت عصور الركود بسوء الفهم، وتحويل التدين إلى حالة تعويض عاطفي أو انسحاب نفسي من ميادين الفعل والإنتاج. وتشدد المقدمة على أن ترديد مقولة أن الإسلام «دين العلم» لم يعد كافيًا، ما لم يقترن بوعي حقيقي بسنن التغيير، وبقراءة دقيقة لأسباب الفجوة العلمية والتقنية.
وتطرح المقدمة أسئلة حادة حول موقع المتخصصين الملتزمين بالإسلام داخل مشروع الأمة الحضاري: كيف يُستثمر التخصص العلمي لخدمة العقيدة وبناء القوة الحضارية؟ ولماذا انكفأت طاقات كبيرة عن مواقع البحث والتخطيط والتصنيع، تحت ضغط تصورات قاصرة عن الدعوة، أو فهم مختل لفرض الكفاية، أو شعور زائف بالذنب أمام الانخراط في العلوم الحديثة؟ كما تنتقد اختزال الاهتمام في الخطاب الوعظي والانفعالات الدينية، مقابل إهمال مراكز التأثير الحقيقية التي يصنعها العلماء والتقنيون ومؤسسات البحث. ومن هنا تأتي هذه المقدمة بوصفها إطارًا فكريًا موجِّهًا لقراءة العمل كله على أنه دعوة لإعادة بناء الوعي برسالة العلم في الإسلام ووظيفته الحضارية.العلم في الإسلام وتشخيص المشكلة
العلم في الإسلام وتشخيص المشكلة
ولعل من نافلة القول: التأكيد على أن الإسلام اعتبر طلب العلم فريضة، واعتمد حسن توظيفه وسيلة لبناء الحضارة المثلى، ذلك أن الإنجاز الحضاري التاريخي كان مرتبطا باستمرار بمدى استجابة المسلمين للخطاب الإلهي، وارتفاعهم إلى مستوى إسلامهم، وحاجات عصرهم، وأن عهود الركود والتخلف والتقليد كانت تلقي بظلالها على فهم المسلمين للخطاب الإسلامي، وإدراك أبعاده.
وقد لا يكون مجديا كثيرا التأكيد على أن الإسلام دين العلم والمعرفة بعد أن أصبح الأمر بدهية على مستوى التصور والتطبيق التاريخي، إضافة إلى أن معضلة التخلف العلمي والتقني التي تعاني منها اليوم، لا تحل بكثرة الشكوى والنواح على الماضي، والبكاء على الأطلال، وخاصة عندما ينقلب البكاء إلى لون من ألوان التداوي والتخدير، ولا يصل بصاحبه إلى مرحلة القلق الحضاري، الذي يؤدي إلى استشعار التناقض والتحدي بين الواقع القائم والمثال المأمول ويبصر بالسبيل المحقق للهدف.
كما أن المشكلة لن تحل أيضا بمزيد من المواقف الخطابية العاطفية، أو الحماس والتوثب الروحي فقط، وإنما لا بد من الإدراك الكامل لمشكلة التخلف، ودراسة المناخ الذي مكن لها، ومعالجة الأسباب، وما يقتضيه ذلك من الصبر والدأب والمراجعة وتصويب الخطو، وعدم الاقتصار على الإحساس بالظواهر والأعراض.
تفنيد دعوى التعارض بين الدين والعلم
وقد يكون صحيحا أن المنتمين للإسلام، الملتزمين بشرائعه، [ ص: 8 ] استطاعوا إلى حد بعيد كسر الحاجز النفسي، وأمكنهم التخلص من المحاصرة، والخروج من المناخ الذي أريد لهم، وضرب على عالمهم: من أن العلم والتقنية يناقض الدين والتدين، وأن سبب التخلف والرجعية والانكسار الحضاري، كامن في الإيمان بالدين، وبمقولاته الغيبية. وبإمكاننا القول هـنا: إن أعداء الإسلام استطاعوا استيراد المعارك التي دارت بين العلماء ورجال الكنيسة، أي: بين الحضارة والكنيسة في العصور الوسطى، إلى المناخ الإسلامي، في محاولة لتحقيق النصر الذي حدث هـناك، إنهم استوردوا المعركة التي لم يكن الإسلام طرفا فيها، ليستوردوا انتصارات موهومة، دون وعي بالميراث الثقافي، والشخصية الحضارية التاريخية، والإنجازات العلمية للأمة الإسلامية. ومشكلتهم الأساسية أنهم اعتمدوا الحضارة الغربية ومقولاتها مقياسا لكل دين وحضارة.
المتخصصون الملتزمون وسؤال التوظيف الحضاري
نقول: لقد استطاع الملتزمون بالإسلام، حل تلك المعادلة التي كانت تبدو صعبة بين الدين والعلم، وأمكنهم فعلا التحقق بأدق الاختصاصات، واعتلاء أرقى المنابر العلمية، والمساهمة في الإبداع والاختراع، مع احتفاظهم بهويتهم الثقافية، وانتمائهم الإسلامي والتزامهم الشرعي، ولو حاولنا الآن القيام بإحصاءات للمتفوقين بالاختصاصات العلمية النادرة في العالم العربي والإسلامي، لوجدنا معظمهم من الملتزمين إسلاميا؛ لأن الإيمان وفر لهم طاقاتهم، وأحسن توجيهها، وضبط سلوكهم، وأكسبهم الطمأنينة وسكينة النفس، وكلها شروط مطلوبة للإنجاز العلمي، بينما نرى الآخرين يحملون الخيبة والفشل، ويحاولون استدراك نقصهم وتخلفهم، وفشلهم بالانتماء إلى أفكار وهيئات ومؤسسات تصنع الشهرة وتساهم بالوصول إلى السلطة، والأضواء التي نراها لبعض النماذج أقرب إلى صناعة الأجنبي، وهي بعيدة أصلا عن الساحة العلمية.
يضاف إلى ذلك، أن التقدم العلمي والتقني الذي يتضاعف اليوم كل عشر سنوات تقريبا لم يسجل إصابة واحدة على الخطاب الإسلامي، [ ص: 9 ] ومعرفة الوحي بعد خمسة عشر قرنا، بينما لم يستطع النص الديني المعمول به قبل الإسلام، الصمود أمام العلمية البسيطة، وسقط عند الصدمة الأولى.
ومع ذلك يبقى السؤال الكبير المطروح هـنا: هـل استطاع الملتزمون بالإسلام الذين أمكنهم التحقق بأدق الاختصاصات واعتلاء أرقى المنابر العلمية، توظيف واستثمار هـذا التخصص في خدمة العقيدة وصناعة الحضارة، وتحقيق كسب مقدور لأمتهم؛ أي جعل الاختصاص العلمي في خدمة العقيدة والدعوة والمبادئ الإسلامية؟ لا شك بأن الإجابة الدقيقة حول هـذا السؤال تقتضي استقصاء للعديد من العوامل الداخلية والخارجية، واستقراء للمعوقات على أكثر من صعيد أيضا، وإن كنا نعتقد أن الإصابة الذاتية الداخلية تبقى هـي الأساس، والعامل المؤثر: ( قل هـو من عند أنفسكم ) [آل عمران:165]. وعلى الرغم من أنه قد يكون للملتزمين بالإسلام بعض العذر لما هـم عليه؛ لأنهم انشغلوا بخاصة أمرهم، وحماية أنفسهم، ومواجهة العداوات والكيود لهذا الدين التي استنفدت معظم طاقاتهم، إلا أنه لا بد من القول أيضا: بأن الكثير منهم عجزوا عن امتلاك الرؤية الشاملة لوسائل وآفاق الدعوة إلى الله لسبب أو لآخر، وبذلك حاصروا أنفسهم قبل أن يحاصرهم أعداؤهم.
تضييق مفهوم الدعوة وترك مواقع التأثير
إنهم لم يروا للدعوة إلى الله إلا طريقا واحدا، وموقعا واحدا، ولونا واحدا من ممارسة الخطابة والوعظ والإرشاد.. إلخ، وبذلك انفصلوا بتصورهم الخاص للدين عن الحياة بمواقعها المتعددة، ولم يدركوا أهمية مؤسساتها المختلفة، ولم يحتملوا ما تقتضيه المرابطة في الآفاق المتعددة من صبر، ومصابرة، ومجاهدة، وثمار بعيدة الأجل، فتركوا الكثير من المواقع العلمية،، ووقفوا جميعا في وجه العواصف السياسية التي تحاول اقتلاعهم، ولم يستطيعوا تماما أن يدركوا أهمية التخصص العلمي ومراكزه ومؤسساته، وضرورته، وجعله في خدمة الدعوة إلى الله، وأنه من أهم الوسائل المعاصرة للنفوذ إلى المواقع المؤثرة، والنفاذ إلى المجالات المتعددة.. وقد [ ص: 10 ] لا نأتي بجدية إذا قلنا بأن العلماء والتقنيين اليوم هـم الذين يحكمون العالم فعلا، ويقررون مصيره، وأن الذين يحتلون مراكز البحث العلمي والأكاديمي هـم صانعو القرار والموقف السياسي في نهاية المطاف، وأن القرارات السياسية لم تعد تنشأ في فراغ، وإنما هـي ثمرة لما تقدمه مراكز المعلومات، ولسنا بحاجة لإبراز دور اليهود ومدى تأثيرهم في هـذا المجال، وأن جيش العلماء من اليهود في مراكز البحث العلمي والمخابر والجامعات ومؤسسات تطوير الأسلحة، كان ولا يزال هـو المؤثر في رسم السياسات العالمية على مستوى الشرق والغرب معا.
الفروض الكفائية واختلال الأولويات
ومن الأمور التي لا بد أن نعرض لها في هـذا المجال، أن المسلمين اليوم بشكل عام – كثمرة للتخلف والعجز – نراهم أكثر حرصا على الفروض العينية منهم على الفروض الكفائية؛ حيث تقع قضية العلم والتقنية، بل قد تستغرقنا وتشغلنا أحيانا بعض المستحبات والمندوبات، على حساب الفروض والواجبات، وقد يستنكر بعضنا على المقصر في بعض المندوبات والمستحبات ما لا يستنكر على المتقاعس في أداء الواجبات والفروض الكفائية! وبذلك انكفأنا عن الكثير من المواقع العلمية المؤثرة، إضافة إلى انحسار ساحة الفروض الكفائية في تصورنا للفروض.
وهذه من الإصابات التي لحقت بالشخصية المسلمة، والتي لا بد من علاجها؛ ذلك أن التخلص العلمي والتقني في التصور الإسلامي، ليس شرطا للنهوض، وبناء المستقبل، وتحقيق الاستقلال، والتخلص من التبعية والتحكم الأجنبي فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى البعد الديني، والمسلك الأخلاقي الذي يترتب على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب والتأثم، إنه من الفروض الكفائية. ومن المعلوم أن فرض الكفاية واجب اجتماعي تكافلي مسئوليته ذات بعدين: بعد فردي، بحيث يصبح فرض عين على من باشره وتوجه إليه إذا تعين قيامه بهذا الفرض لكفاية الأمة؛ وبعد اجتماعي؛ لأن أداءه منوط بأفراد المجتمع جميعهم، ثوابا في حالة الكفاية، وعقابا في حالة العجز والعطالة. [ ص: 11 ]
وقد عرف علماؤنا فرض الكفاية بأنه: الأمر الذي إذا قام به بعض المسلمين، سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه أثموا جميعا. وكلمة (قام به) فسرت في عصر التخلف العلمي بمجرد مباشرته، سواء تحققت الكفاية أم لا، حتى لم ير الكثير من مسلمي التخلف اليوم مثالا لفرض الكفاية إلا صلاة الجنازة، ولعل ذلك لأننا في حالة موت وتخلف كما يقول الشيخ الغزالي ، أما العلوم والفنون والصناعات والزراعات وما إلى ذلك فهي خارج دائرة اهتمامنا، إننا نحسن استيرادها واستهلاكها.
والحقيقة أن الذي نفهمه من معنى "إذا قام به"، أي: إذا أداه على الوجه الأكمل، فلا تبرأ الأمة المسلمة من الإثم ما لم يكن فيها من المتخصصين والعلماء والتقنيين بقدر كفايتها، هـذا إذا لم نقل بمسئوليتها تجاه الإنسانية عامة التي تقتضيها القيادة والشهادة.
عقدة الذنب وتعطيل التخصص
ومن الإصابات البالغة التي لحقت بالشخصية المسلمة اليوم أن الكثير ممن اختاروا الطريق العلمي أو التقني كفاية لأمتهم، وتحقيقا لأداء ما تقتضيه أمانة الاستخلاف والاستعمار في الأرض، ونتيجة لمناخ التخلف والفهم الديني المحزن، والعجز، بدأ يشعر بعقدة الذنب تجاه دينه وإسلامه، لاعتقاده بأن طريق العلم والتقنية، مناقض لطريق الدعوة والعمل إلى الله، فما عليه إذن إلا أن ينسحب من الساحة، ويتوقف عن المتابعة في جامعته ومعهده، ومخبره، ليتحول إلى واعظ ومرشد، ومفسر وفقيه، يدخل نفسه في أمور كثيرة قد يقتضيها الاختصاص الدقيق واستحضار الأدوات الضرورية اللازمة للفهم وهو لم يتحقق بها، وبذلك يزيد المسلمين تخلفا على تخلفهم، واضطرابا وبعثرة وتمزقا، ويدع مكانه واختصاصه معطلا، ظنا منه بأن عمله لا يقع ضمن التكاليف الشرعية. والأدهى من ذلك كله، ظن بعض المسلمين أن وجودهم في موقع الاستهلاك ووجود أعدائهم في موقع الإنتاج والتصنيع من نعم الله عليهم (!!) لأن الله سخر لهم الأعداء لخدمتهم، إنها معطيات التخلف والانحطاط والتدين المغشوش المغاير للمسيرة الحضارية الإسلامية وسائر إنجازاتها. [ ص: 12 ]
النظرة إلى الحضارة المعاصرة
يضاف إلى ذلك أن بعضنا قد لا يرى من الحضارة المعاصرة – التي جاءت ثمرة لتقدم العلم والتكنولوجيا – إلا عيوبها. وتكبر هـذه السلبيات في عينه وتكبر، حتى تصل به إلى ضرب من الحلم والوهم (حلم اليقظة) ، بأنه هـذه الحضارة سوف تئول إلى السقوط والانهيار لمصلحته، وما عليه إلا أن يمارس حالة الانتظار، ويعفي نفسه من أي دور ومسئولية، أو تحقيق أية خصائص تؤهله للتبادل الحضاري. فالحضارة علم وتقنية، فكر وفعل ومعارف إنسانية متبادلة، وتراكمات علمية مستمرة، وخصائص وصفات نفسية تؤهل للقيام بالدور المطلوب، أما الرؤية النصفية التي تقتصر على الولع بتتبع العيوب، وتكبيرها، والاقتصار على ذلك وانتظار سقوطها لمصلحتنا، فهو لون من خداع النفس، وتكريس واستمرار لواقع العطالة. ولا يفوتنا أن نذكر بأن بعض علماء الحضارة أكثر إحساسا بسلبياتها منا، وهاجسهم الدائم البحث عن سبيل العلاج.
وعلى الجانب الآخر ومن خلال العجز نفسه الذي يورثه مناخ التخلف، لا يرى بعض المسلمين اليوم من الحضارة المعاصرة إلا إنجازها وإبداعها، وتقدمها على مختلف الأصعدة، إلى درجة يصاب معها بضرب من العمى العلمي عن أزمة إنسان هـذه الحضارة، وإصاباته المتعددة، والسلبيات الكثيرة التي ترافقت مع هـذا التقدم العلمي.
فيعيش حالة العجز الكامل، ويسيطر عليه ذهان الاستحالة فيفتقد بذلك أية قدرة على الإنجاز أو الأمل بالإنجاز مستقبلا. والمحصلة سوف تكون واحدة في نهاية الأمر، بين من لا يرى إلا العيوب، فينظر السقوط لمصلحته، وبين من لا يرى إلا الإنجاز والإبداع، فينبهر بتقدم الآخرين ويلغي نفسه تماما.
عدا عن كثيرا من المسلمين اليوم، يظنون أن مشكلة التقدم العلمي والتقني، يمكن أن تحل بمزيد من الحماس والإخلاص والتوثب الروحي فقط، بعيدا عن فقه آيات القرآن، وهدي النبوة، وسيرة السلف العملية: كيف تعاملوا مع الأسباب، وأدركوا علل الأشياء، وسنن التغيير، وقوانين التسخير. [ ص: 13 ]
أما البكاؤون، الذين يبكون على الأطلال، وينسحبون من الساحة، ويستغرقهم الحديث عن إنجازات السلف، والافتخار بها، فإنهم يساهمون بشكل سلبي – وربما عن حسن نية – بالإحباط والانكسار النفسي، وتكريس الهزيمة التكنولوجية أمام التحدي القائم.
الإعجاز العلمي وحدوده
وقد يكون الوجه الآخر للقضية، وكلون من التعويض عن مواجهة الواقع، والعجز عن الإبداع، والاحتماء بميراث الماضي، والوقوف عند حدوده، دون القدرة على تجاوز الماضي إلى الحاضر، وتعدية الرؤية الحضارية، ما نراه اليوم من التوسع فيما اصطلح على تسميته: الإعجاز العلمي للقرآن، على الرغم من بعض التحفظات على هـذه التسمية لدى الكثير من علماء المسلمين، الذين يرون أن ميدان الإعجاز في القرآن ليس في المجال العلمي أصلا، فالعلم في تقدم، وتطور مستمر. وقد بلغ اليوم شأوا واسعا، وكلما تقدمت الأيام تتبلور الحقيقة العلمية أكثر.
وخلود الرسالة الإسلامية يعني فيما يعنيه، خلود المعجزة، وعدم قدرة الإنسان على الإتيان بمثلها، وأظن أن تطبيق ذلك في ميدان الإعجاز العلمي سيؤدي إلى الكثير من المفارقات والتمحلات.
والقرآن كتاب هـداية أولا وقبل كل شيء، وليس كتاب علم وتكنولوجيا. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن القرآن عرض لبعض الحقائق العلمية، ولفت نظر الإنسان إليها، ليحقق هـدفه في الهداية، ويفتح طريق البحث العلمي أمام المسلمين، وأن هـذه الحقائق لم تكن معلومة في عصر نزول القرآن، وأن العلم أثبتها بعد آماد وآماد.
وقد يؤكد العلم كل يوم ما يكسبنا الاطمئنان إلى صحة النص القرآني، ولا شك أن الحقائق العلمية التي عرض لها القرآن في عصر الأمية العلمية تعتبر من دلائل النبوة وبرهان صدقها، أما تسميتها إعجازا فأظن أن القضية ليست بهذه السهولة والبساطة. ومن طبيعة العلم التطور، وكلما تطور حقق إنجازات وحقائق أكثر بكثير من الماضي كله.