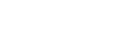يتوقف الدكتور العلّامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» عند قضية حاسمة في التربية الإيمانية: كيف ينظر المسلم إلى إخوانه؟ هل يتهمهم دائمًا بسوء النية، أم يحسن الظن بهم ما داموا على أصل الإسلام؟
في هذا المقطع من الكتاب، يوجّه القرضاوي نصيحة خاصة لـ«أبناء الصحوة» كي يخلعوا «المنظار الأسود» في رؤيتهم للناس، ويبنوا حكمهم على ثلاثة أسس: فهم طبيعة الإنسان وضعفه، والالتزام بالحكم بالظاهر وترك السرائر لله، ثم الإيمان بأن المعصية لا تقتلع الإيمان من جذوره. ويستشهد في ذلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وقصص من السيرة، ترسم منهجًا متوازنًا بين التحذير من المعصية والرحمة بالعصاة.
الإنسان يخطئ.. ورحمة الله أوسع من الذنب
المنطلق الأول عند القرضاوي هو تذكير الشباب بأن الناس بشر، لا ملائكة. هم مخلوقون من «حمأ مسنون»، يتعثرون وينهضون، يخطئون ويصيبون، كما قال النبي ﷺ: «كل بني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون».
ويستشهد القرضاوي بقصة أبينا آدم عليه السلام، التي يصفها القرآن بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (طه: 115)
فإذا كان أول البشر قد نسي ووقع في المخالفة، فلا غرابة أن يقع أبناؤه في الذنب، وأن يحتاجوا إلى من يفتح لهم باب الأمل بدل إغلاقه.
لذلك يركّز القرضاوي على الآية العظيمة التي لا يجوز أن تغيب عن خطاب الدعوة والتربية: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر: 53)
يتوقف القرضاوي هنا عند خطاب «يا عبادي»؛ إذ يراها نداء إيناس وتكريم، ينسب فيه الله تعالى هؤلاء المسيئين إلى نفسه، ويقرّبهم من ساحته، ثم يفتح باب المغفرة لكل الذنوب، مهما عظمت، ما دام باب التوبة مفتوحًا.
الحكم بالظاهر وترك السرائر لله
القاعدة الثانية التي يؤكدها القرضاوي هي أن المسلم مأمور بالحكم بالظاهر، وترك ما في القلوب لله. من شهد أن «لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» حُكم له بالإسلام ظاهرًا، ويُترك باطنه لعلام الغيوب.
يستدل على ذلك بحديث النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».
هذا الميزان هو الذي جعل النبي ﷺ يعامل المنافقين في المدينة بأحكام الإسلام الظاهرة، مع أنه يعلم نفاقهم الباطن. كانوا يكيدون له في الخفاء، ومع ذلك لم يخرجهم من دائرة الصحبة الظاهرية، ولم يسقط عنهم أحكام الجماعة.
وحين اقترح بعض الصحابة قتْل هؤلاء المنافقين، رفض ﷺ ذلك؛ خشية الفتنة وسوء الظن العام، وقال كلمته المشهورة: «أخشى أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه».
القرضاوي يربط هذا الموقف بمسألة سوء الظن: إذا كان النبي ﷺ لم يفتح باب الشك في إسلام المنافقين، مع علمه بنفاقهم، فمن الأولى ألا يفتح شباب الصحوة باب الاتهام في إيمان عموم المسلمين لمجرد معصية أو تقصير ظاهر.
الإيمان لا يزول بالمعصية.. شواهد من السيرة
النقطة الثالثة عند القرضاوي هي أن كل من آمن بالله ورسوله لا يخلو من خير في داخله، مهما غلبته المعصية، ما لم يكن مستحلاً لها أو متحديًا لله تعالى. المعصية تجرح الإيمان وتنقصه، لكنها لا تقتلعه من جذره بمجرد وقوعها.
ولهذا يقدّم أمثلة عملية من السيرة النبوية:
الشاب الذي استأذن في الزنا
يذكر القصة المشهورة: جاء فتى من قريش إلى النبي ﷺ يستأذنه في الزنا. ثار الصحابة واستنكروا جرأته، لكن النبي ﷺ لم يطرده، بل قال له: «ادنُ». ثم حاوره بهدوء:
«أتحبه لأمك؟»
قال: لا والله، جعلني الله فداك.
قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم».
ثم كرر السؤال عن ابنته وأخته وعمته وخالته، وفي كل مرة يقول الفتى: لا والله، فيجيبه النبي ﷺ: «ولا الناس يحبونه لكذا». ثم وضع يده على صدره ودعا له: «اللهم اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصِّن فرجه».
القرضاوي يعلّق بأن النبي ﷺ رأى في هذا الشاب خيرًا كامنًا، وتعامل مع معصيته كطارئ يمكن علاجه بالحوار والدعاء، لا كهوية ثابتة تستوجب الإقصاء واللعن.
الغامدية وتوبة تضرب مثلًا
المثال الثاني: المرأة الغامدية التي زنت وهي محصنة، وحملت من الزنا، ثم جاءت إلى النبي ﷺ تطلب إقامة الحد عليها لتتطهر. بعد أن أقيم عليها الحد، بدر من خالد بن الوليد سبّ لها، فقال له النبي ﷺ: «أتسبّها يا خالد؟ والله لقد تابت توبة لو قُسِّمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل تجد أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟»
القرضاوي يستخرج من هذا الموقف أن المعصية مهما عظمت لا تحجب باب التوبة، وأن حسن الظن بالتائب فريضة، بل إن النبي ﷺ جعل توبتها ميزانًا للآخرين.
مدمن الخمر الذي «يحب الله ورسوله»
المثال الثالث: رجل من الصحابة ابتلي بشرب الخمر، وكان يُؤتى به إلى النبي ﷺ فيُقام عليه الحد مرة بعد مرة. في إحدى المرات، قال أحد الصحابة: «ما له، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به!».
فردّ النبي ﷺ بقوة: «لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله». وفي رواية أخرى قال: «لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم».
القرضاوي يلفت الانتباه إلى أمرين هنا:
• النبي ﷺ لم ينفِ عنه صفة «الأخوة» الإيمانية رغم المعصية المتكررة.
• نهى عن لعنه؛ لأن اللعن يدفعه بعيدًا عن جماعة المؤمنين، فيقترب من الشيطان أكثر.
بهذا الفهم، يصبح واجب المسلم أن يفتح باب التوبة أمام العاصي، لا أن يدفعه دفعًا إلى اليأس أو الردّة.
ضد التكفير واللعن.. ومع إصلاح القلوب
في ختام هذا المقطع، يوجّه القرضاوي نقدًا حادًا لمن يكفّرون الناس بالمعاصي، أو يلعنون العصاة ليلًا ونهارًا. يذكّرهم بأن كثيرًا ممن يحكمون عليهم بالكفر أو الفسق قد يكونوا:
• جهّالًا يحتاجون إلى تعليم.
• أو ضعفاء وقعوا تحت ضغط صحبة أو بيئة منحرفة.
• أو غافلين شغلتهم الدنيا، يحتاجون إلى تذكير لا إلى طرد.
اللّعن ـ كما يوضح ـ لا يصلح الناس، بل يزيدهم بعدًا، بينما المطلوب هو الدعوة، والنصح، والدعاء بالهداية، لا رمي الناس في أحضان الشيطان.
ويختم القرضاوي نصيحته لأبناء الصحوة بكلمة شعيب عليه السلام، لتلخّص روحه في هذا الحديث كله: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: 88)
بهذه الروح، يدعو القرضاوي الشباب إلى ترك منطق التكفير وسوء الظن، واعتماد منهج النبوة: رحمة بالعصاة، وثقة بأن في قلوب المسلمين بقية من خير، تحتاج إلى من يوقظها لا من يحكم عليها بالإعدام.