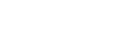مع مرور خمسة عشر عامًا على ثورة 25 يناير 2011، تعود مصر إلى سؤالها الأصعب: هل كانت تلك الأيام حلمًا جميلاً وانتهى، أم بداية حقيقية ما زالت موجتها القادمة في الطريق؟ ما بين محاولات رسمية محمومة لشيطنة الثورة وطمس معناها، وأصوات حرة تصر على الاحتفال بها كأعظم ما فعله هذا الشعب في تاريخه الحديث، تبدو ذكرى يناير اليوم معركة على الذاكرة والمعنى بقدر ما هي استعادة لحدث سياسي.
في هذا التقرير تتجاور شهادات فنانين ومفكرين ونقابيين وشباب عاشوا الميدان، ليصنعوا لوحـة واحدة: يناير ليست “خطأً تاريخيًا” كما تريد السلطة، بل جرح مفتوح وأمل مؤجل، وثورة حيّة اختُطفت ولم تمت.
ثورة حية في الوجدان: من كابوس الطغاة إلى وعد الموجة القادمة
الفنان عمرو واكد يكتب على منصة “إكس” معايدة لا تشبه رسائل المناسبات الباردة، بل بيانًا ثوريًا مكتملًا: يصف ثورة يناير بأنها “المذلّة لكل المستبدين، كابوس الطغاة، الساحقة لراحة اللصوص”، ويؤكد أنها “لن تموت، وستظل كامنة حتى تجمّع موجتها التالية حيث لا مفر منها”. هنا لا يتعامل واكد مع الثورة كذكرى ماتت، بل كطاقة كامنة تنتظر لحظة انفجار جديدة.
كل عام وكل الأحرار بخير وبصحة وعزيمة، ثورة يناير المذلّة لكل المستبدين، كابوس الطغاة، الساحقة لراحة اللصوص، الملحمة في أخذ الحق المشروع، المسيلة لعرق الرهبة أثناء خطابهم اللزج وهم تحت تأثير الترامادول، ثورة يناير لم ولن تموت، وستظل كامنة حتى تجمّع موجتها التالية حيث لا مفر منها.
— Amr Waked (@amrwaked) January 25, 2026
على النهج ذاته، يستعيد حزب “تكنوقراط مصر” كلمات الفنان أحمد عيد: “مش نادم على نزول 25 يناير، ولو حصلت هنزل تاني، لو عايزين تعتبروني طابور خامس أنا طابور خامس”. في جملة قصيرة يلخص عيد شعور شريحة واسعة ممن شاركوا في الثورة: لا اعتذار، لا ندم، بل استعداد متجدد لدفع الثمن نفسه، في مواجهة خطاب سلطوي لا يملك إلا سلاح التخوين.
أما الأكاديمي والوزير السابق محمد محسوب فيضع يناير في سياق أخلاقي وإنساني نادر، فيقول إنها كانت “عظيمة في شروقها في 2011 وكريمة في غروبها في 2013”، مؤكّدًا أنها قدمت التضحيات من دون أن ترفع يدًا بالأذى أو تدعو إلى عنف، وأن من خرجوا لإحياء بلدهم لا يمكن أن يكونوا خصومًا لأبنائه. بهذا التوصيف يسحب محسوب بساط الشرعية الأخلاقية من تحت سردية “الفوضى والخراب” التي يُراد إلصاقها بالثورة.
كانت ثورة يناير عظيمة في شروقها في ٢٠١١ وكريمة في غروبها في ٢٠١٣،
— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) January 25, 2026
قدمت التضحيات دون أن ترفع يدا بأذى أو تدعو لعنف،
الشهداء والمفقودون والمختفون والمعتقلون من أبنائها بكل انتماءاتهم،
فمن هب ليحيي بلده لا يؤذي أبناءها،
الحقائق لا تبددها التهيؤات.
وبين صوت فنان يسخر من المستبدين، وفنان آخر يعلن عناد الانتماء ليناير، ووزير سابق يضع الثورة في إطارها الأخلاقي، تتأكد فكرة واحدة: يناير لا تُختزل في “مؤامرة” ولا تُختصر في “حلم ساذج”، بل تجربة بشرية كاملة صنعت معيارًا جديدًا للمروءة والكرامة.
بين القديسين والشياطين: الميدان كحالة روحية لا تنتهي
حساب “ألش خانة” يختار عنوانًا لافتًا: “مسّنا الحلم من ١٥ سنة”، ثم يقتبس وصفًا لمصر بأنها “أرض القديسين والشياطين”، بلد يجتمع فيه الفساد المتطرف والصلاح المتطرف. يرى أن 25 يناير كانت اللحظة التي تجلّى فيها أنقى ما في هذا الشعب؛ حين صار ميدان التحرير مساحة نادرة للنقاء والإخلاص والعمل الجماعي بعيدًا عن منطق المصلحة الضيقة.
النقابي والطبيب محمد فتوح عوض يذهب أبعد من الحنين، فيكتب كما لو أنه لا يزال في الميدان حتى الآن: رغم المنافي والمطارات وضباط الجوازات، يقول إنه “لم يغادر التحرير”، وإنه يعيش حياته اليومية في العمل والبيت لكنه في داخله ما زال جالسًا على الرصيف، يسند ظهره إلى السور الحديدي، ينتظر إعلان الرحيل الحقيقي لمبارك بوصفه عقلية ونظامًا لا مجرد شخص.
فتوح يصف كيف يحاول أن يعيش بأخلاق التحرير: في احترام الناس، في شغفه بعمله، في استعادة لحظات علاج المصابين وتقاسم “البقسماط والشاي باللبن” مع رفاقه، كأن الزمن تجمّد في لحظة كرامة جماعية لا يريد السماح لها بالذوبان.
في المقابل، يعترف أن كثيرين غادروا الميدان وانضموا إلى معسكر البلطجة أو اللامبالاة، بينما ظل آخرون “مزروعين في أسفلت التحرير”.
ثم تأتي استعارة عمر المصري لقصة بني إسرائيل بعد الخروج من قبضة فرعون لتقول إننا نعيش حالة تيه تشبه ما بعد النجاة: شعوب خرجت من تحت حذاء المستبد، لكنها ما لبثت أن عبدت “عجلاً جديدًا”، وحنّت إلى أيام فرعون، متناسية أن التيه لم يكن بسبب الخروج، بل بسبب خيانة الفكرة والارتماء في حضن سامري جديد.
في هذه الأصوات الثلاثة تتجسد مفارقة يناير: ثورة صنعت لحظة تطهير روحي وأخلاقي نادرة، لكن أجيالًا كاملة ما زالت عالقة بين الحلم الأول وواقع التيه والارتداد.
شرخ لا يلتئم: يناير كشبح يطارد “المجتمع المُعسكر”
الأكاديمي والكاتب عبد الرحمن الجندي يستعيد صورة له مراهقًا في الميدان، ينظف الشوارع ويطلي الأرصفة بعد التنحي. يعترف أنه اليوم ينظر إلى تلك اللقطة بمزيج من السخرية والشفقة على “سذاجة” تلك الأيام، لكنه يصر في الوقت نفسه على أن ما فعله لم يكن سذاجة، بل تعبيرًا عن إحساس نادر بالملكية والانتماء: أن الشارع “شارعنا”، وأن البلد ملك للناس لا لعصابة حاكمة.
يضع الجندي هذه المشاعر في سياق أطول يبدأ من انقلاب 1952 وصعود “المجتمع المُعسكر”، حيث صارت مصر مقسومة إلى “نسور” و”مدنيين”، إلى طبقة حاكمة عسكرية تعلو فوق المجتمع، وطبقة محكومة لا تملك إلا الطاعة. في هذا السياق، تبدو ثورة يناير أول شرخ حقيقي في “طبيعة الأشياء”، اللحظة التي جرّب فيها الملايين لوهلة أن البلد يمكن أن تكون ملكًا لهم، وأن “النسر” يمكن أن يُجبر على الانكسار. ولهذا، يراها الجندي شبحًا سيظل يطارد السلطة، لأن جدار الهيبة كُسر مرة، وما ينكسر مرة يمكن أن ينكسر ثانية.
من زاوية أخرى، يستعيد شريف محيي الدين ثورة يناير عبر بوابة الأغنية والوجدان؛ يحكي عن صديق عاشق لمحمد منير أصيب بخيبة لأن منير لم يكن على قدر اللحظة الثورية، لكنه يقرأ التجربة ككل كأغنية طويلة من الحب المؤلم بين المصريين وبلدهم؛ حب يواصل رغم الخذلان.
يصف الميدان كمعجزة تنظيم وتحضر: لجان شعبية تحمي الشوارع في غياب الشرطة، تعايش نادر بين فئات متناقضة، مسيحيين يحرسون صلاة المسلمين، فتيات يمشين بحرية غير مسبوقة، كتلة حرجة من المواطنين العاديين صنعت حدثًا لن تنساه السلطة، لذلك تلاحقه حتى اليوم بحملات تشويه لا تتوقف.
في النهاية، ما تكشفه هذه الشهادات المتفرقة أن يناير ليست مجرد تاريخ على الجدول، بل شرخ في بنية الاستبداد لم يُغلق بعد: فنان يرى فيها كابوسًا للطغاة، وزير يعتبرها أرقى ما قدّمه هذا الشعب، طبيب يعيشها كحالة مستمرة، مفكر يربطها بتاريخ “المجتمع المعسكر”، وأغانٍ تضعها في خانة الحب الجريح الذي لا ينتهي.
خمسة عشر عامًا لم تكفِ لدفن الثورة، بل زادتها وضوحًا: النظام تغيّر شكلاً، لكن جوهره لم يتغير، والشرخ الذي صنعته يناير في هذا الجدار لا يزال يذكر الجميع بأن إمكانية التغيير حقيقة تاريخية، لا مجرد حلم عابر في ليل طويل.