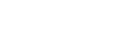مع كل 2 فبراير تعود صورة الخيول والجِمال وهي تقتحم ميدان التحرير، ومع 1 فبراير تعود مدرجات استاد بورسعيد الملطخة بالدم. ليست هذه مجرد تواريخ على رزنامة، بل جرح مفتوح في ذاكرة المصريين، وامتحان مؤجل لعدالة لم تكتمل.
وقعت موقعة الجمل في 2 فبراير 2011، بينما كانت البلاد تحت حكم حسني مبارك رسميًا، لكن الجيش على الأرض كان اللاعب الأهم. وبعد عام واحد تقريبًا، في 1 فبراير 2012، كانت مصر تحت الحكم المباشر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي تولى إدارة شئون البلاد من 12 فبراير 2011 حتى 29 يونيو 2012، بصفته رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع. في تلك الفترة كان عبد الفتاح السيسي قد عُيِّن مديرًا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع منذ عام 2010، أي أنه كان مسؤولًا عن واحدة من أهم عيون وآذان الدولة الأمنية أثناء الثورة وما تلاها.
لهذا، فإن الأسئلة السياسية والأخلاقية عن مسؤولية طنطاوي والسيسي لا تتعلق فقط بما فعلوا، بل أيضًا بما كان في مقدورهم أن يمنعوه ولم يمنعوه، من مذبحة في استاد مغلق، إلى انسحاب مفاجئ فتح الطريق لهجوم بالخيول والجمال على اعتصام سلمي.
مذبحة بورسعيد 1 فبراير 2012: استاد تحت السيطرة ودماء بلا حماية
في مساء 1 فبراير 2012، تحوّلت مباراة بين الأهلي والمصري في استاد بورسعيد إلى مجزرة راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي على الأقل، بحسب تقارير صحفية وحقوقية عديدة. أغلقَت أبواب الخروج، تعطلت مخارج الطوارئ، انطفأت الأضواء في بعض اللحظات، وغاب تدخل فعّال من قوات الأمن الموجودة نظريًا لتأمين المباراة.
شهادات الناجين ومقاطع الفيديو تظهر تدفق مجموعات تحمل أسلحة بيضاء وعصيًّا إلى أرضية الملعب، ثم صعودها إلى مدرجات جمهور الأهلي، بينما بدا الأمن متراخيًا أو منسحبًا من المشهد في لحظات حاسمة. لم يكن الاستاد ساحة مفتوحة بلا سيطرة، بل منشأة مغلقة تخضع لإجراءات تفتيش وبوابات إلكترونية وأجهزة أمنية متعددة. السؤال البسيط الذي لم يُجب حتى اليوم: من سمح بدخول هذا الكم من الأسلحة؟ ومن ترك الأبواب تُغلق على الضحايا بدل أن تُفتح لهم؟
رغم أن القضاء أدان بعض المسؤولين الأمنيين وأثبت وجود تقصير جسيم من الشرطة، فإن المساءلة توقفت عند مستويات متوسطة، ولم تقترب من مناخ الإدارة الأمنية والسياسية العام الذي سمح بالجريمة. في ذلك الوقت، كان المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي، وكان وزير الدفاع (طنطاوي) ورؤساء الأجهزة السيادية – ومنهم مدير المخابرات الحربية (السيسي) – مسؤولين سياسيًا عن منظومة أمن يُفترض أنها تعرف ماذا يجري في الملاعب كما في الشوارع.
ذاكرة المجزرة حية على المنصات الرقمية
يمكن لمن يريد استعادة بعض مشاهد تلك الليلة أن يشاهد مثلًا:
• توثيق وتحليل في برنامج «الصندوق الأسود» عن مذبحة بورسعيد:
• لقطات مباشرة من الفوضى بعد المباراة:
• تغريدات في ذكرى المجزرة تربط ما حدث بمناخ حكم المجلس العسكري ومسؤوليته السياسية:
— الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) February 2, 2025
هذه الشهادات البصرية لا تجيب عن سؤال: من أصدر القرار؟ لكنها تُظهر بوضوح أن ما جرى لم يكن «خناقة كروية» عابرة، بل جريمة في ملعب تحت سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية.
موقعة الجمل 2 فبراير 2011: انسحاب الجيش وفتح الميدان للخيول
قبل عام واحد من مذبحة بورسعيد، كان المشهد في قلب القاهرة. في 2 فبراير 2011، نفذ مؤيدون لمبارك هجومًا بالجمال والخيول والبغال على متظاهري ميدان التحرير، وخلّف الهجوم قتلى ومصابين بالمئات، بحسب التوثيق الحقوقي والصحفي. ما ميّز هذا اليوم لم يكن فقط عنف البلطجية، بل قرار الانسحاب أو الحياد من جانب قوات الجيش التي كانت تطوّق الميدان في الأيام السابقة.
فجأة، فُتحت ممرات، وتراجعت مدرعات، وبدت الساحة مهيّأة لدخول المهاجمين من اتجاهات معروفة، بعضها قادم من نزلة السمان كما وثقت تقارير عدة. هنا يصبح السؤال السياسي مباشرًا: من يملك قرار سحب القوات وفتح الطرق؟ الجيش – ممثلًا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة – كان الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ مثل هذا القرار. وفي الوقت الذي كان فيه طنطاوي على رأس المجلس ووزيرًا للدفاع، كانت المخابرات الحربية بقيادة السيسي أحد أهم مصادر المعلومات والتقدير الأمني. القول إن كل ذلك جرى دون علم أو تقدير من هذه المستويات العليا يبدو، على الأقل، بعيدًا عن المنطق.
مقاطع الفيديو التي وثقت اليوم لا تزال شاهدة على تنظيم الهجوم: مجموعات منظمة، رجال يحملون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، ومعهم لافتات وصور مبارك. يمكن مشاهدة جانب من هذه اللقطات في:
• لقطات من داخل الميدان أثناء الهجوم:
• توثيق بصري للحظة دخول الخيول والجمال وسط المتظاهرين:
• فيديو قصير على فيسبوك يروي كيف حاول النظام كسر اعتصام التحرير:
كل ذلك يشير إلى أن ما جرى لم يكن «احتكاكًا عفويًا» بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين، بل عملية منظمة اُستخدم فيها العنف لكسر الاعتصام وإرسال رسالة مفادها: الحرية ثمنها الدم.
«الطرف الثالث» ومنطق الدولة العميقة: من صناعة الصدمة إلى إعدام العدالة
بعد موقعة الجمل ومذبحة بورسعيد، استند خطاب السلطة طويلًا إلى شماعة «الطرف الثالث»؛ ذاك الكيان الغامض الذي يُلام على كل جريمة ثم يتبخر بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي. لكن التوثيق الصحفي والحقوقي على مدى السنوات كشف أن الفاعلين لم يكونوا أشباحًا، بل شبكة من البلطجية، ورجال أعمال، ومسؤولين حزبيين وأمنيين تحركوا في ظل غطاء سياسي وأمني واضح.
الفكرة الجوهرية هنا أن المسؤولية لا تُختزل في من حمل العصا أو السلاح الأبيض، بل تمتد إلى من صنع المناخ وترك الأبواب مفتوحة للجريمة: من قرر سحب الجيش من محيط الميدان، أو تقليص أعداد الشرطة في الاستاد، أو غضّ الطرف عن دخول الأسلحة، أو ترك الكاميرات وأجهزة الإنذار بلا استخدام. هذه قرارات لا تُتخذ في مستوى ضابط أو مدير أمن فقط، بل ضمن منطق حكم كامل يرى في الثورة خطرًا وجوديًا.
وفق هذا المنطق، لم تكن بورسعيد ولا موقعة الجمل استثناء، بل جزءًا من سياسة «صناعة الصدمة»؛ استخدام العنف المفرط لزرع الخوف في المجتمع، ودفعه إلى تفضيل «الاستقرار بأي ثمن» على استمرار المسار الثوري. وعلى الرغم من المحاكمات، التي انتهت غالبًا ببراءة المتهمين الرئيسيين في موقعة الجمل، وبأحكام متباينة في قضية بورسعيد، ظل الإحساس العام أن «الرؤوس الكبيرة» لم تقترب من قفص الاتهام أبدًا. على المنصات الاجتماعية، يتكرر هذا الإحساس في كل ذكرى، عبر منشورات وتغريدات تصرّ على تسمية من يُعتبرون أصحاب القرار، وتربط بين طنطاوي والسيسي وبين مناخ القمع الذي مهّد لهذه الجرائم:
• تغريدة تربط مذبحة بورسعيد بالمجلس العسكري وقياداته:
مذبحة بورسعيد
— محمد منتصر (@montaseregy) February 1, 2026
72 روحًا قُتلت عمدًا بأبواب مُغلقة وأمنٍ متواطئ وقرارٍ بالقتل.
المجلس العسكري هو القاتل .. وطنطاوي سيظل يذكره التاريخ بأن يديه ملوثة بدماء هؤلاء الشباب .
وأن من نفّذ ومن تستّر شركاء في الجريمة.
الدم لا يُنسى والذاكرة أقوى من الرصاص
والقصاص قد يتأخر… ولكنه لن…
• وتغريدة أخرى في ذكرى موقعة الجمل تصفها بأنها من أخطر محطات ثورة يناير:
في الذكرى الـ15 لموقعة الجمل..
— قنــــاة مكملين - الرسمية (@MekameleenMk) February 2, 2026
نشطاء يستعيدون إحدى أخطر محطات ثورة يناير، والتي راح ضحيتها 14 شهيدًا وأصيب خلالها قرابة 1500 شخص. pic.twitter.com/CXJyH6kR1g
في النهاية، تبقى مذبحة بورسعيد وموقعة الجمل شاهدتين على مرحلة قررت فيها السلطة مواجهة شعبها بالسلاح بدل السياسة. الاتهام السياسي والأخلاقي الموجَّه للمشير حسين طنطاوي وعبد الفتاح السيسي – باعتبارهما رأس السلطة العسكرية والأمنية في تلك اللحظات – ليس بحثًا عن انتقام، بل عن معنى للعدالة وحق للضحايا في الحقيقة.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن لمصر أن تتصالح مع مستقبلها من دون كشف كامل للحقيقة، ومحاسبة من كانوا في قمة هرم القرار يوم سالت الدماء؟ أم أن الصمت سيبقى هو الجريمة المستمرة التي تُضاف إلى جرائم القتل ذاتها؟