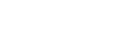طلال أبو غزالة
رجل أعمال أردني، خبير في المعلوماتية والملكية الفكرية
قفز سؤال قديم إلى واجهة الأحداث بعد عملية خطف الرئيس مادورو في كاراكاس: هل تسعى الولايات المتحدة إلى سرقة نفط فنزويلا، البلد الغني بالاحتياطيات؟ قد يبدو سؤالًا جذّابًا في صيغته، لكنّه ينهار سريعًا عند إخضاعه لميزان الجيولوجيا والاقتصاد والتكنولوجيا؛ إذ تقول الحقيقة إن نفط فنزويلا ليس بئرًا مفتوحة ولا محطّة وقود تنتظر من يمسك بالمقبض ويبدأ بالضخ، بل هو (حرفيًا ومجازيًا) عبء ثقيل لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، ولا حتى استثماره من دون كلفة باهظة ومخاطر ممتدّة.
وعليه، ليس النفط في فنزويلا القصة الكاملة، بل عنصرٌ في معادلة أوسع تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية مع صراع النفوذ بين الولايات المتحدة والصين. والحقيقة أن واشنطن لا تنظر إلى كاراكاس بوصفها محطة وقود، وإن كان هذا صحيحًا جزئيًا، بل تراها جزءًا من عقيدة مونرو التاريخية التي تقوم على اعتبار نصف الكرة الغربي مجالًا حيويًا خاصًا بالولايات المتحدة، ومنصة نفوذ لقوة منافسة تعمل بهدوء ومنهجية لترسيخ حضورها في أميركا اللاتينية.
وصحيحٌ أيضًا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرى أن إطلاق العنان لثروة فنزويلا النفطية قد يسهم في خفض أسعار الطاقة ووقف مسار الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية الصينية، أما الواقع فيقول إن نفط هذا البلد ليس حلًّا سريعًا ولا أداةً فورية، فعامل الزمن بين ضخّ الاستثمارات وبدء الإنتاج التجاري قد يمتدّ سنوات، وهذه المدّة عامل مخاطرة بحد ذاته. ما نعرفه أن بكين ضخّت خلال العقدَين الماضيَين قرابة 60 إلى 70 مليار دولار في كاراكاس، معظمها في صورة قروض مضمونة بالنفط، ما جعلها لاعبًا ماليًا وتقنيًا، حتى في ظلّ تراجع الإنتاج. وحتى هذه الاستثمارات لم تحقق عوائد نفطية مستقرّة بعد، لكنّها منحت الصين موطئ قدم استراتيجيًا في منطقة تعتبرها الولايات المتحدة حديقةً خلفيةً لها، ومجالًا حيويًا لأمنها. وعليه، يصبح النفط أداة ربط لا غاية نهائية: أداة لتمويل النفوذ، وتأمين الإمدادات طويلة الأجل، وبناء شبكات لوجستية وتقنية تمتدّ آثارها إلى ما هو أبعد من البرميل نفسه.
نظريًا، تملك فنزويلا أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، وتُقدَّر بنحو 300 مليار برميل، غير أن هذا الرقم (المهم في السجالات السياسية) يخفي خلفه حقيقة أساسية، أن ما يقارب 90% من هذه الاحتياطيات نفط فائق الثقل، أقرب في خصائصه إلى الإسفلت منه إلى الخام التقليدي؛ أي أنه لا يتدفّق تلقائيًا من باطن الأرض، ولا يُضخّ عبر أنابيب عادية، بل يحتاج عمليات معقّدة تشمل الحقن بالبخار، والمعالجة الكيميائية، ومنشآت ضخمة لتحسين النوعية قبل التصدير.
واقتصاديًا، يعني ذلك أن كلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط الفنزويلي الثقيل قد تتجاوز 40 إلى 50 دولارًا في أفضل الأحوال، مقارنةً بنحو 10 إلى 15 دولارًا في دول أخرى، مثل دول الخليج العربي، أو أقلّ من 30 دولارًا في بعض حقول الصخر الزيتي الأميركية. ومع تقلّب أسعار الطاقة، وحديث الانبعاثات والطاقة المتجدّدة، يصبح النفط الفنزويلي أقلّ جاذبيةً وغير مُجدٍ استثمارًا طويلَ الأجل.
ولو افترضنا أن العائق الجيولوجي يمكن تجاوزه، فإن قطاع النفط الفنزويلي يعاني تآكلًا عميقًا تراكم عبر عقود. فمنشآت كاراكاس، التي كانت يومًا من بين الأكثر كفاءة في أميركا اللاتينية، لم تخضع لصيانة منتظمة منذ أكثر من نصف قرن لأسباب عديدة، منها الحصار الأميركي. وتفيد تقديرات خبراء الطاقة بأن إعادة تأهيل القطاع تتطلّب استثمارات لا تقلّ عن 100 إلى 120 مليار دولار، موزّعةً على سنوات طويلة، لتشمل تحديث الحقول وبناء مصافٍ جديدة، وإصلاح شبكات النقل والتخزين. ولا يمكن اعتبار هذا الرقم "إعادة تأهيل"، بل هي إعادة بناء شبه كاملة. والسؤال هنا ليس تقنيًا فقط، بل هو ماليّ أيضًا: من سيتولّى تمويل هذا العبء في دولة يُقدَّر دينها الخارجي بنحو 170 مليار دولار، وتعاني من تضخّم مزمن، وانكماش اقتصادي حادّ، وهجرة ملايين من قواها العاملة؟
لذا كانت نتائج اجتماع ترامب مع عمالقة النفط الأميركية الأسبوع الماضي مخيّبةً لآماله؛ فحين يعرض الرئيس أحد أكبر الاحتياطيات النفطية على وجه الأرض، ثم يخرج الاجتماع بلا التزاماتٍ ماليةٍ تُذكر، تكون الرسالة أوضح من أيّ حديث. وعليه، يصبح الحديث عن وضع اليد على آبار النفط أقرب إلى تسطيح لواقع أكثر تعقيدًا؛ فالولايات المتحدة تدرك من الأساس أن السيطرة السياسية لا تعني بالضرورة جدوى اقتصادية، وأن النفط الفنزويلي في حالته الراهنة لا يخفّف التضخّم العالمي ولا يوفّر إمدادات رخيصة، بل هو مشروع طويل النفس.
السؤال هنا: إذا لم تكن شركات النفط العملاقة الرابح الأول، فمن المستفيد إذن؟ توحي التجارب التاريخية بأن الرابحين المحتملين ليسوا منتجي الخام بقدر ما هم مقدّمو الخدمات: شركات خدمات حقول النفط، والمقاولات الهندسية، والخدمات اللوجستية. وفي العراق بعد 2003 مثال واضح: فبينما بقيت عملية الإنتاج محكومة بتحدّيات عديدة، حققت شركات مثل هاليبرتون و"كي بي آر" مليارات الدولارات من عقود الإعمار والصيانة وإدارة المنشآت، بعيدًا عن تقلّبات أسعار النفط نفسها.
ويمكن أيضًا، من هذه الزاوية، اعتبار فنزويلا "أكبر ورشة إصلاح محتملة" في قطاع الطاقة العالمي، والنفط هنا ليس الهدف المباشر، بل الذريعة الاقتصادية لمشروع أوسع يتداخل فيه الاستثمار وإعادة الإعمار ونقل التكنولوجيا. وهذا النوع من المشاريع (إذا تحقق) ستكون له آثار مباشرة في سلاسل الإمداد العالمية، وفي تدفّقات الاستثمار، وربما في أسواق العمل في قطاع الخدمات الهندسية، أكثر ممّا سيكون له أثر فوري في أسعار الوقود أو معدّلات التضخّم، خاصةً أن إعادة تأهيل قطاع الطاقة الفنزويلي، إن حدثت، ستحدّد وجهة الصادرات، والعملة المستخدمة، والتكنولوجيا المعتمدة في الاستخراج، وسلاسل التوريد المرتبطة بها... وهذه كلّها عناصر تقع في صلب المواجهة الأميركية - الصينية.